عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
رواية «السيح» لمجدي دعيبس: الرواية كفعل مقاومة في زمن الاشتباك السردي
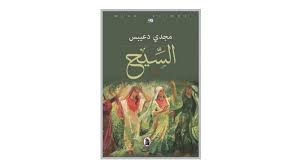
الدستور-منذر كامل اللالا
في رواية «السيح»، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، وهي الجزء الثالث من ثلاثية الثورات التي دأب الروائي مجدي دعيبس على كتابتها بدءاً من رواية «الوزر المالح» التي تغطي فترة الثورة العربية الكبرى ونهاية الحرب العالمية الأولى، وبالإصدار الثاني «قلعة الدروز» التي تغطي الثورة السورية الكبرى عام 1925، يواصل الكاتب مشروعه في «السيح» ليغطي الفترة من عام 1936 إلى 1945، ضمن ما يُعرف بالإضراب الكبير ضد الإنجليز وما تلاه من تصاعد هجمات العصابات الصهيونية، لا يكتفي دعيبس بتوثيق فصول من الثورة الفلسطينية، بل يبتكر بنية سردية قائمة على ما يمكن تسميته بـ»الاشتباك السردي»، وهي خاصية تتبدى في تداخل الأصوات والأزمنة والمسارات، حيث تتقاطع المصائر الفردية في مساحات مشتركة من النضال، وتتشابك التواريخ الصغيرة مع السرد الوطني العام، عدا عن اشتباك الواقعي بالمتخيل.
السيح ليست مجرد رواية مكان، بل رواية تداخل الأزمنة والأدوار والمصائر، وهنا تكمن عبقريتها السردية، ما يميز «السيح» هو قدرة الكاتب على تفكيك الحدود التقليدية بين الأنواع السردية، فنحن لسنا أمام رواية سياسية بحتة، ولا رواية شخصية تمامًا، بل أمام نص يشبه الأرض التي يكتبها: متعدد الطبقات، محفوف بالمنعطفات، وملغوم بالذكريات، إن «الاشتباك السردي» في الرواية يُلغي الحدود بين الداخل والخارج، بين الشخصي والجمعي، بين البيت والساحة، بين الأنثى والذكر، بين الماضي والحاضر.
إن «الاشتباك السردي» هنا ليس مجرّد تشعب في الحبكة أو انتقال بين الشخصيات، بل هو نظام سردي عضوي يجعل من كل شخصية قناة لتمرير صوت المرحلة، وكأن الرواية تشبه السيح نفسه؛ تجويف صخري واسع تتجمع فيه مياه الأحداث، وتصمد فيه الذكريات والتضحيات حتى مواسم الجفاف السياسي، بهذا المعنى، يكون السيح، مكاناً ورمزاً، هو التكوين السردي الأول الذي تتقاطع فيه الأصوات، فالسيح عبارة عن «تجويف صخري هائل الذي ينداح إليه المطر «. هذه الاستعارة المائية تتحدّى الجمود، وتدفع بالسرد إلى فضاء رمزي تُختبر فيه حدود المعنى واللغة، وتُصبح فيه الرواية شهادة على الذاكرة.
يتجسد هذا الاشتباك أولاً في الجغرافيا، حيث تتحول الأمكنة إلى كيانات حية لا تعرف حدود فواصل الانتداب، فقصة الفتيين «مقبول» و»سند»، ورحلتهما من جبال عجلون الأردنية إلى فلسطين، ليست مجرد انتقال، بل هي تجسيد للحمة المكان، فالجبال والسهول، ومخاضات نهر الأردن، ليست مجرد خلفية للأحداث، بل هي شرايين حية تحمل نبض المقاومة وتوحّد المصير، تقول الرواية على لسان «مقبول» وهو يعبر القرى باتجاه جنين: «كانت القرى تتوالى مثل حبات السبحة، قريبة من بعضها بعضا، قطعنا سهول القمح الصفراء بعد حصادها، وتلالا من شجر الزيتون واللوز... الشمس تتلألأ في سماء مكشوفة، نسيم لطيف يهب من الغرب كل حين ليبرد جباهنا المتعرقة»، هذا الوصف لا يرسم خريطة، بل ينسج علاقة عضوية بين الأمكنة، ويؤكد على وحدة الجغرافيا، وتتجلى هذه الفكرة بشكل أكثر وضوحاً في الحوار بين «بهيجة» و»مقبول» وهما في أعلى الجبل: «أتعرف ذاك الجبل؟ على ذمة أبي درة هذا جبل عجلون... وهذا جبل الكرمل.. على ذمتي هذه المرة»، هذا الحوار يُلغي الحدود المبتدعة ويُعيد للأرض وحدتها التاريخية والطبيعية، ويؤكد على أن فلسطين ليست مجرد اسم في التاريخ، بل هي ذاكرة تتجدد، واشتباك لا ينتهي.
ولا يكتمل هذا النسيج السردي المتشابك إلا بحضور المرأة الفلسطينية التي وثقت الرواية نضالها من عتبة الغلاف، مروراً بالإهداء الذي يخلّد شهيدات المقاومة، فقد دخلت المرأة الفلسطينية التاريخ من أوسع أبوابه، فكانت المحرّضة والمناضلة والمقاتلة والشهيدة. وتأتي شخصية «بهيجة» التي ترافق الثوار وتقاتل وتنقل الأخبار والمؤن، لتكسر القوالب النمطية للمرأة في السرد التاريخي، فشخصيتها ليست مجرد فدائية، بل هي فتاة تُفجّر غضبها بعد مقتل أختها «تركية» أمام عينيها، حيث تقول: «أمام ناظري اسودت الدنيا بوجهي ولم أعد أرى سوى الانتقام»، ويتحول حزنها إلى حقد يُنتج فعلاً مقاوماً، ما يجعلها تقول عند وصفها لمقبول: «لو أن السماء تمطر فتيانا مثله لكسرنا شوكة الانجليز وعصابات اليهود منذ سنوات»، هذه الجملة تُلخّص عمق التوق إلى الوحدة والعمل المشترك، هذا الحضور يثبت أن المرأة الفلسطينية شريك أساسي في عملية البناء والإنتاج المعرفي والميداني، وهي جزء لا يتجزأ من معركة التحرير والبناء، ما يجعلها تمثيلاً حياً للمرأة المقاتلة التي يعيد النص الاعتبار إليها، لا بوصفها رمزاً، بل بوصفها فاعلاً في الجغرافيا والمصير.
وفي قلب هذا التشابك الجغرافي، يتداخل الاشتباك الإنساني، فالرواية لا تقدم أبطالاً خارقين، بل شخصيات عادية تُشكّل جزءاً من نسيج جماعي. فـ»بهيجة» لا تُقرأ وحدها، بل من خلال علاقتها بـ»مقبول» و»سند» و»أبو درة»، كما أن «أبو درة»، القائد يوسف سعيد صالح الجرادات، لا يظهر بوصفه شخصية درامية فحسب، بل كرمز مقاوم يتجاوز الجغرافيا والتقسيمات، فهو الاسم الذي يُتداول على ألسنة الشخصيات كمنارة للنضال، ويقود المبادرات لتصفية الخلافات بين الفصائل الثورية، وتتجلى رؤيته الأخلاقية عندما يرفض قتل الأطفال، قائلاً في رسالته: «العرب لا يقتلون الأطفال»، هذا التأثير يجعله تمثيلاً حياً لفكرة أن البطولة ليست دائماً بالحضور الجسدي، بل بالتأثير الذي يزرعه القادة في الوعي الشعبي، ما يبرز في حديث بهيجة مع مقبول: «الم تسمع بأبي درة في جبال عجلون؟ الم تسمع ما يردده الناس: فلسطين لا تفزعي نجمك في السما درة»، هذا الحوار لا يُشير فقط إلى معرفة جغرافية، بل إلى وعي عميق بوحدة الأرض التي يحرسها أبو درة في سيرة الأجيال.
وفي مقابل هذا الحضور الفاعل، نجد «سند» الذي يقع في قبضة الإنجليز، ويتحول جسده في سجن عكا إلى ساحة معركة، في مواجهة التعذيب الوحشي، يُصر على المقاومة، ويدفع جسده إلى أقصى حدود التحمل، ما يُدهش حتى محقّقيه: «لا أصدق ما يحدث... مات الكثيرون لتعذيب أقل من الذي نلته، أنت حالة فريدة». ويُجيب الراوي على لسان سند: « ورق الشجر الذي يسقط على الارض بعد أن تداهمه برودة الخريف لم يفعل ما يستحق الاعجاب لأنه يمضي في دورة مرسومة، لكن سند رفض المسار الذي رسموه له، عاند الموت ليصنع منه حياة جديدة «، هذا الصمود ليس مجرد بطولة، بل هو فعل وجودي يرفض القبول بالمسار المرسوم، ويؤكد أن إرادة المقاومة تولد من رحم الألم وتُعيد بناء الذات، أما أخوه «مقبول»، فيمثل الفعل العفوي الذي ينقذ بهيجة ويقاتل الجنود، ليُجسّد بذلك فكرة أن النضال ليس دائماً عملاً منظماً، بل يمكن أن يكون قراراً لحظياً نابعاً من الوجدان الجمعي.
في قالب لغوي ثري وبليغ، يعتمد الروائي على لغة تجمع بين شاعرية الوصف وقوة العبارة، دون أن يفقد النص تماسكه التاريخي، يستخدم دعيبس تقنيات سردية متعددة، كتيار الوعي الذي يكشف عن الدوافع الداخلية للشخصيات، والحوار الذي يعكس عمق الصراع، والوصف الذي يبني عوالم بصرية نابضة بالحياة، لتنتج لنا رواية تجمع بين دقة المؤرخ وخيال الكاتب في وثيقة نضالية تبقى خالدة.
في المحصلة، لا يمكن قراءة رواية «السيح» بمعزل عن كونها صرخةً أدبيةً في وجه النسيان، وإعادة تدوين لذاكرة جمعية ترفض التجزئة، إنها رواية تتجاوز وظيفتها السردية لتكون وثيقةً حيةً، لا تُصوّر فقط أحداثاً من الماضي، بل تُجدّد الوعي بضرورة الاشتباك مع الحاضر والمستقبل، فبين «السيح» كرمز للمصدر والجذر، و»فلسطين» كرمز للمصير والهدف، تنسج الرواية لوحةً سرديةً متكاملة تؤكد أن النضال هو نهرٌ متصل لا تجف مياهه، وأن البطولة ليست حكراً على الأساطير، بل هي كامنة في صمود الأفراد وتضحياتهم، وعليه، فإن لأدب يبقى شاهداً أميناً على هذه الحقيقة الخالدة، ويؤكد أن السرد يمكن أن يكون آخر جبهات المقاومة.
