عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"الكتاتيب في الأردن".. كيف أسست لوعي اجتماعي وتعليمي متجذر؟
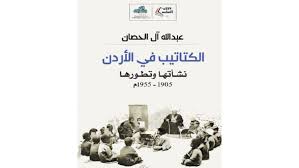
الباحث عبدالله آل الحصان يضيء في كتابه على تجربة تعليمية فريدة
الغد-عزيزة علي
يسلط الباحث الأردني عبدالله آل الحصان، الضوء في كتابه "الكتاتيب في الأردن: نشأتها وتطورها 1905-1955م"، على تجربة تعليمية فريدة شكلت قاعدة لنهضة المجتمع الأردني منذ مطلع القرن العشرين.
ويتناول الباحث آل الحصان، نشأة الكتاتيب وتطورها، ويستعرض شيوخها وأدوارهم، وأساليب التعليم التي اعتمدت عليها، وصولًا إلى الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي أسهمت في تكوين جيل من المتعلمين المؤثرين في مجتمعاتهم.
كما يوثق الكتاب الذي صدر ضمن سلسلة فكر ومعرفة التي تصدرها وزارة الثقافة، حياة تعليمية مرت بها الأجيال، وجسر لفهم جذور التعليم التقليدي وأثره في بناء الشخصية والمعرفة، بعيدًا عن المدارس الرسمية، حيث ظل للكُتّاب دورٌ اجتماعي وثقافي لا يُستهان به.
في مقدمته للكتاب، يوضح الباحث أن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها محاولة جادّة لتوثيق نشأة وتطوّر الكتاتيب في الأردن خلال الفترة (1905-1955م)، وتسليط الضوء على هذه الكتاتيب وشيوخها، مع إبراز جوانبها الفنية والإدارية.
وقد حرص الباحث على أن يستند في دراسته إلى أوثق المصادر والمراجع الموضوعية، والوثائق الرسمية والخاصة، فضلًا عن المقابلات الشخصية.
ويتحدث آل الحصان عن الصعوبات التي واجهته في هذه الدراسة، وتمثلت في ندرة المصادر والمراجع التي تناولت الكتاتيب في الأردن خلال الفترة (1905-1955م). ويعود ذلك إلى أن معظم الدراسات السابقة ركزت على التعليم الحكومي وأهملت التعليم التقليدي. كما برزت صعوبة أخرى في رصد هذه الكتاتيب وتوثيقها، إذ إن عددًا كبيرًا منها كان يعمل دون ترخيص، مما حال دون وجوده في السجلات الرسمية. وزادت الصعوبة مع عدم معرفة الاسم الكامل لشيخ الكُتّاب أو تحديد الفترة التي عمل خلالها في مكانٍ ما بدقة. وعليه، فقد جاءت هذه الدراسة لتكون الأولى من نوعها في هذا المجال، حيث اهتمت برصد هذا النوع من التعليم ضمن فترة زمنية محددة، وتناولت مختلف الجوانب الفنية والإدارية والتشريعية وغيرها، لتسد بذلك النقص الحاصل في الدراسات التاريخية والاجتماعية ذات الصلة بالموضوع.
ويقول الباحث إنه بذل جهدًا مضنيًا في سبيل الحصول على المعلومات اللازمة لهذه الدراسة. وهو يلتمس العذر من أي شيخ لم يرد ذكره ضمن هذه الفترة، إذ لم يكن ذلك إلا لعدم وجود اسمه أو اسم كُتّابه في المصادر والمراجع أو في الوثائق الرسمية والخاصة، كما لم يشر إليه أحد ممن أجريت معهم المقابلات الشخصية من كبار السن أو العارفين بتاريخ التعليم في مناطقهم. وخلص آل الحصان إلى أنه لم يتطرق في هذه الدراسة إلى الشيوخ الذين عملوا وعّاظًا أو اقتصر اهتمامهم على التعليم الديني في شكل حلقات دينية بحتة، دون التوسع في تدريس اللغة العربية والحساب وغيرها، بخلاف الكُتّاب الذي عُرف منذ زمن بعيد بنظامه التعليمي المتكامل.
وفي خاتمة الكتاب يشير المؤلف إلى أنه اعتمد في هذه الدراسة على المصادر والمراجع والوثائق الرسمية والخاصة، إضافةً إلى المقابلات الشخصية، لتسليط الضوء على الكتاتيب في الأردن خلال الفترة (1905-1955م). وقد توصّلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها: " كان للكتاتيب فضل كبير في محو أمّية الكثير من أبناء الأردن، في وقت كانت فيه المدارس نادرة، غير أن هذه الفائدة اقتصرت على الذكور دون الإناث، الأمر الذي جعل نسبة الأمّيات بين الفتيات تكاد تصل إلى 100 % في بعض القرى الأردنية. ويُعزى ذلك إلى العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية التي حالت دون افتتاح كتاتيب خاصة بهنّ، وجعلت تعليم الإناث أمرًا غير مقبول آنذاك.
لم تكن هناك في البداية أيّ رقابة أو تدخّل من الجهات المسؤولة في شؤون الكتاتيب، إذ كانت تُمارَس العملية التعليمية فيها بعيدًا عن إشراف الحكومة العثمانية. وكان لشيخ الكُتّاب حرية مطلقة في إدارة شؤون كُتّابه ومعاملة تلاميذه، فيُدرّس ما يشاء دون اعتراض من أحد، ويعاقب الأولاد بالطريقة التي يراها مناسبة. وبذلك لم تخضع الكتاتيب عند نشأتها لأي نظام رسمي يُلزم أصحابها بالحصول على موافقة أو ترخيص، حيث ظل شيوخ الكتاتيب يزاولون هذا النوع من التعليم الخاص من دون التقيّد بشروط تحددها إدارة المعارف في حكومة شرق الأردن. أما ابتداءً من عام 1935م، فقد تغيّر هذا الحال، إذ أُنيطت بإدارة المعارف مهمّة تعيين شيخ الكُتّاب بعد استيفائه مجموعة من الشروط المقرّرة.
وقد عُرفت أسماء هذه الكتاتيب في المجتمع الأردني باسم الشيخ الذي كان يُدرّس فيها، فيقال: "كتّاب الشيخ فلان"، أو "كتّاب الخطيب فلان"، أو "كتّاب الخجا فلان". وكانت الكتاتيب قبل ظهور التعليم الرسمي وسيلة تعليمية مناسبة لتلبية احتياجات المجتمع المتنوّعة، وأدت دورًا بارزًا في الحفاظ على اللغة العربية ونشرها.
إذ كان التلاميذ يتعلمون فيها القراءة والكتابة العربية، والتجويد الصحيح للقرآن الكريم، وتعاليم الدين الأساسية، مع الاهتمام بالتنشئة الدينية والاجتماعية للأطفال. وكانت الكتاتيب بذلك الأداة التي أسست قاعدة من المتعلمين الذين تمكنوا، بعد تخرجهم، من المساهمة في نهضة الأردن في شتى المجالات.
وكان للكتاتيب في الأردن نظام عرفي سائد منذ زمن طويل، واعتاد عدد كبير من شيوخ الكتّاب على ممارسته. واستمر التعليم ضمن هذا النظام حتى بداية ظهور المدارس الحكومية وانتشارها، حيث تراجع دور الكتاتيب تدريجيًا، واختفى بعد صدور قانون المعارف سنة 1955م، إذ بدأت الكتاتيب بالتلاشي. وكان هناك عدد من العوامل التي أثرت في نظام التعليم بالكتاتيب، منها العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أظهرت الدراسة أن التنظيم الإداري والتشريعي للكتاتيب في منطقة الأردن خلال فترة الدراسة أدى دورًا مهمًا في تطور التعليم داخل الكتاتيب.
أما بخصوص الجوانب الصحية، فقد بينت الدراسة اهتمام شيوخ الكتاتيب بنظافة الكتّاب والطلاب، حيث كانوا يفتشون الطلاب يوميًا للتحقق من نظافتهم. كما كانت الحكومة، وبخاصة إدارة المعارف، تولي هذا الجانب اهتمامًا خاصًا، إذ كان أطباء الصحة يقومون بزيارات مفاجئة لمتابعة أحوال الكتاتيب الصحية.
بيّنت الدراسة أن وظيفة شيخ الكتّاب لم تقتصر على تعليم الأطفال القراءة والكتابة والحساب وتحفيظهم القرآن الكريم فحسب، بل تجاوزتها لتشمل أداء وظائف اجتماعية أخرى، نظرًا لكون المجتمع ينظر إلى شيخ الكتّاب نظرة احترام وتبجيل، إلى جانب الترحيب والتقدير.
وقد أظهرت الدراسة أن أجرة شيوخ الكتّاب لم تكن متساوية، بل كانت تعتمد على الهبات التي يتلقونها من أولياء الأمور، والتي كانت غالبًا موادّ عينية تُقدّم كل يوم خميس، وفي نهاية كل شهر كان ولي الأمر يدفع أجرة نقدية متفقًا عليها مع الشيخ. وكان بعض الشيوخ يتقاضى أجره سنويًا، بينما كان البعض الآخر يؤدي عمله مجانًا دون مقابل مالي.
وقدّمت هذه الدراسة عرضًا مفصّلًا بأسماء شيوخ الكتاتيب الذين عُرفوا في الأردن، مع تحديد أماكن كتاتيبهم والفترة الزمنية التي عملوا فيها، سواء كانوا رجالًا أو نساءً. وبيّنت الدراسة أن المناهج الدراسية في الكتاتيب كانت تقتصر في غالبيتها على تعليم القراءة والكتابة الأساسية، وبعض المهارات الحسابية، مع تحفيظ القرآن الكريم الذي يحتل المقام الأول في مناهج الكتّاب.
وأظهرت الدراسة أن الكتاتيب لم يكن فيها أسلوب موحد للتعليم ولا أوقات محددة، بل كانت أساليب الدراسة تخضع لاجتهادات شيخ الكتّاب وقدرات الطلاب. وغلب على التعليم الأداء الجماعي، حيث كان الطلاب يعلّم بعضهم بعضًا، ويقوم الأكبر سنًا منهم بتعليم الأصغر، ثم يعرضون مراحل هذا التعليم على الشيخ يومًا بيوم أو أسبوعًا بأسبوع.
استخدم شيوخ الكتاتيب الثواب والعقاب لتحفيز وضبط الطلاب، مع التركيز على الثواب المعنوي نظرًا لقلة الموارد. ومن أبرز هذه الأساليب التشجيع والمدح والثناء على الطالب أمام زملائه وأهله وأفراد المجتمع المحلي، واختيار الطالب المتميّز ليكون مساعدًا للشيخ في تدريس بقية الطلاب. وعرفت الكتاتيب في الأردن عقوبات قاسية وعنيفة لها آثار سلبية تبعث الخوف في نفوس الطلاب، ودفع بعضهم إلى ترك الكتّاب. ومع ذلك، كان لهذه العقوبات بعض الإيجابيات في دفع الطالب على التعلم وإتقان القراءة والكتابة، إذ لم تكن موجهة إلا للطالب المهمل أو الكسول أو المشاكس، بينما كان الطالب الذكي والمؤدب ينال الاحترام والتقدير من شيوخه.
وكانت أنشطة الكتاتيب متنوعة، فكان هناك أنشطة ثقافية تتعلق بالتثقيف الديني، والأشعار، والأناشيد، والحكايات الشعبية، وكتابة الرسائل وسندات الدين. أما الأنشطة الترفيهية فشملت الألعاب الشعبية وحفلات التخرج.
