عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
بين المقاومة والاستسلام.. الثنائيات الضدية في رواية «نطفة في قلب غسّان كنفاني»
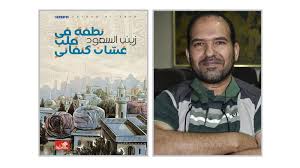
الدستور-منذر اللالا
(ظهري وإنّي لا أقول كسرته/ لكنّ شيئاً من خلالك/ شاءَ كسرَه. الشاعرة الشهيدة: هبة أبو ندى)
« لا شيء أسوأ من أمانٍ زائف يأخذك إلى سعادة وهمية...» تقول ندى، بطلة رواية الرّوائية زينب السعود «نطفة في قلب غسّان كنفاني»، الصّادرة عن دار الأهلية للنشر والتوزيع، تقدِّم الرواية صورة للفلسطيني تستحضر ملامح ما قدّمه الشهيد غسّان كنفاني في مسيرته الإبداعية التي جمعت بين البعد الإنساني والنضالي، حيث تتحوّل الشخصيات إلى مرايا تعكس صورة الفلسطيني في مواجهة تحدياته الوجودية والتاريخية، «كنفاني» الذي حمل فلسطين في نصوصه كجغرافيا وذاكرة، لم يقدّم الفلسطيني بوصفه كيانا مثاليا منزّها، بل ككائن يعيش التوتر بين النقصان والكمال، بين الحلم والخذلان، بين الانتماء والانفصال، ومن خلال السرد المشحون برمزية المكان وأسطرة التجربة، في مواجهة عدوّ متعدِّد الوجوه يثقل على الجسد الفلسطيني بالحصار والقمع والقتل والتشريد.
تدور أحداث الرواية في الضِّفة الغربية وغزّة حول ندى، الموظّفة في وكالة الأونروا، وابنة الأسير رامز أبو دقّة الذي قضى سنوات طويلة في السّجن قبل أن يموت نتيجة الإهمال الطبّي. وُلدت ندى من نطفة مُهرَّبة من السجن، لتلتقي بعد تخرجها برجل يحمل اسمًا مركبًا هو «غسّان كنفاني»، موظّف في مكاتب الأونروا، ابن والد شيوعي وأم يهودية، تحيط به أسئلة معلّقة حول هويّته، وتظلّ حساسيّته المفرطة تمنع أيّ كشف عنها، عبر ثيمات وقضايا متعدِّدة، تتحوّل الرواية إلى مرآة لتجربة فلسطينية مركّبة: من النّطف المهرَّبة التي تتحدّى السجن والزمن، إلى الحواجز التي تفتت الضّفة الغربية وتجعلها جزرًا معزولة، إلى قضية سرقة الأعضاء من المسجونين، ورصد التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية تحت الاحتلال، ووصولًا إلى الطرق الالتفافية والمنظّمات الغربية التي تقف بين الدّعم الإنساني والتوظيف السياسي وليس انتهاءً بحصار غزّة وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال حاليا ومنذ ما يقارب العامين.
تقوم الرواية في ثيمتها المركزية على ثنائية الاستسلام/المقاومة، التي اعتمدتها الكاتبة بوصفها محورًا بنيويًا لكشف التوتر العميق بين نمطين متقابلين من الوعي والسلوك داخل المجتمع الفلسطيني، وقد تجسّدت هذه الثنائية على المستوى الشخصي في علاقة الزوج «غسّان كنفاني»، الذي يميل إلى الاستسلام وقبول الأمر الواقع، بزوجته «ندى رامز أبو دقّة»، التي تتبنّى فكر المواجهة والمقاومة، وعلى المستوى الجمعي، تُحيل هذه الثنائية إلى الانقسام المجتمعي الأوسع بين خيار مسايرة الاحتلال وخيار مجابهته، وما ينطوي عليه كلّ مسار من تبعات وجودية وصراع هوية واصطفافات تهدِّد النسيج الوطني، تُعدّ الثنائيات الضديّة أحد المحاور الأساسية في بنية الخطاب الأدبي، لما تحقِّقه من ربط بين طرفين متناقضين يكشفان عمق المفارقة ويوسعان آفاق الدلالة، فهي أداة فنية تعكس تعقيدات الواقع، وتُثير لدى المتلقّي وعياً نقدياً يوازن بين القيم المتضادة، وقد أشار ليفي شتراوس إلى أنّ الثنائيات الضدية تمثل آلية ذهنية وثقافية لفهم العالم عبر بناء المعنى من التناقضات، وفيما يلي بعضا من ملامح الثنائيات في الرواية:
استسلام غسّان في مقابل مقاومة ندى، في قلب الرواية، تتجلّى أولى الثنائيات في علاقة الزوجين. ندى، التي ترى في البقاء في فلسطين فعل حياة ومعجزة يومية، تصطدم دومًا برغبة غسّان في الرحيل نحو كندا، حيث «الأرض التي تتّسع لأحلامه» وغياب الحواجز والإضرابات. تتساءل ندى: «هل كان خائنًا لقضيتنا؟»، بينما يرد غسان ببرودة: «أنا مجرد إنسان عادي أريد أن أحيا بسلام... لا أريد أن أكون بطلاً»، هذا التباين يختزل الصراع النفسي بين جيل يعيش المعاناة كحافز للمقاومة، وجيل آخر يراها مبررًا للانسحاب من المواجهة.
وطن/ منفى: ترى ندى أن جغرافيتها الشخصية هي امتداد لجغرافيا الوطن، وأنّ الدفاع عن الأرض يبدأ من غرس أسمائها في ذاكرة الأجيال، رفضت أنْ تُسمى ابنتها «ريتا» الاسم الذي اختاره غسّان مفضلة اسم «جنين» لما يحمله من رمزية كفاحية، بينما يصرّ غسّان على اسم عصري «مودرن» ومنفصل عن الذاكرة الجمعية، مبرراً ذلك ببراغماتية تنظر إلى المكان من منظور العائق لا الحافز، تتحوّل معركة الأسماء هذه إلى استعارة مكثّفة لمعركة الذاكرة الفلسطينية في مواجهة محوها الرمزي.
إيمان بالمعجزة مقابل واقعية باردة: تتكرّر في الرواية ثنائية أخرى، تتمثّل في نظرة ندى إلى المعجزات كقوّة يومية قادرة على قلب موازين القهر، مقابل تشبّث غسّان بعقلانية جامدة، عند حاجز الولادة في نابلس، تقول ندى: «ربما تحدث معجزة ويفتح الحاجز»، فيرد غسّان غاضبًا: «قليلاً من الواقعية يا ندى»، هذه الفجوة الفكرية تعكس اختلاف فلسفتين في النظر إلى الحياة تحت الاحتلال: فلسفة تتشبّث بالأمل كضرورة للبقاء، وأخرى ترى فيه وهماً يطيل المعاناة.
ذاكرة/ نسيان: ندى لا تفصل بين حياتها الخاصة وسياقها التاريخي، فتربط الأغاني التراثية، وأسماء المدن، وحكايات المجازر بمسارها الشخصي. في المقابل، يسخر غسّان من هذه «الحالة الأثيرية»، معتبرًا التراث عبئًا عاطفيًا يعطل المضي قدمًا. هذا التضاد يفتح سؤالًا عميقًا حول دور الذاكرة في تشكيل الهوية: هل هي مصدر قوّة، أم قيد على الحركة نحو المستقبل؟
الخطاب الأيديولوجي مقابل البراغماتية الفردية: في نقاشهما حول سماسرة الأراضي، تتّخذ ندى موقفًا مبدئيًا حادًا ضد أي تعاون مع الاحتلال، بينما يبرِّر غسان السلوك بدوافع المصلحة الاقتصادية، منتقدًا ما يسميه «شعارات الصحف والخطابات القومجية». هنا تشتبك الثنائيات على مستوى اللغة نفسها: لغة المقاومة التي تنتمي للفضاء العام، ولغة المصلحة الفردية التي تنحاز إلى النجاة الشخصية.
يلخص غسان عقدته حين يقول: «مشكلتك أنّك تظنّين أنّي غسّان كنفاني فعلاً»، رافضًا أن يحمل إرث كاتب تحوّل إلى رمز وطني. إنّه يصرّ على إنسانيته العادية، بينما تريده ندى في مقام البطل المقاوم. هذه المفارقة تعكس إشكالية «الأيقنة» في الثقافة الفلسطينية، حيث تتحوَّل الشخصيات العامة إلى مرجعيات أخلاقية تقاس عليها الأفعال الفردية.
في نطفة في قلب غسان كنفاني، لا تقدم زينب السعود ثنائياتها بوصفها خطوطًا فاصلة صلبة، بل كمساحات توتر تتخللها محاولات عبور فاشلة أو مؤجّلة، ندى وغسّان ليسا مجرّد شخصين على طرفي نقيض (رغم أنّ النهايات تنبئ بأنّ الحبّ ما يزال يجمعهما معا)، بل هما تجسيد لجدلية فلسطينية أوسع: كيف نوازن بين حقّ الفرد في حياة آمنة وحقّ الجماعة في بقاء الذاكرة والمكان؟ الرواية، بذلك، لا تحاكم بقدر ما تكشف هشاشة الخيارات، وتعيد للقارئ حقه في التأمّل: هل يمكن أنْ تنتصر المقاومة على الاستسلام دون أنْ تسحق إنسانية من يختار الانسحاب؟ أم أنّ كلا الطرفين، في النهاية، يعيشان تحت سقف واحد من القهر، يوزِّع الظلال بعدل على المقاوم والمنسحب معا؟
هي ندى المقاومة، وهي أيضًا صدى لهبة أبو ندى، الشاعرة الشهيدة، التي آمنت بالمعجزات كما آمنت ندى، وكانت ترصدها وهي تفتح لها الأبواب المغلقة، تلك المعجزات التي تشبه ما قصده محمود درويش في مديح الظل العالي حين قال: «وحّدنا بمعجزة فلسطينية» فلا أقل من معجزة يحقِّقها أبناء فلسطين انتصارا لكفاحهم وانتصارا للشهداء.
« نطفة في قلب غسّان كنفاني» واحدة من الروايات التي تجعلك تتمهّل في قراءتها كي لا تنتهي، وتشوِّقك نحو لحظة الكشف، فلا تفرج عن أسرارها إلّا في فصولها الأخيرة، تمتاز بسلاسة الأسلوب، وبنية لغوية متينة مشبعة بالمجاز، ومعالجة فنية بعيدة عن التكلّف، تجعل من الرواية عملا متكاملا، ضمن قالب سردي جذاب ومثير، يحمل همّ فلسطين في قلب الحكاية، ويعيد للمعجزة الفلسطينية حضورها في وجدان القارئ.
