عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
"الكشاف" لنسيبة يستعرض النهج الفلسفي وأثره بالمجتمع الفلسطيني
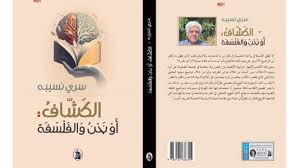
الغد-عزيزة علي
لا يقدم كتاب "الكشاف: أو نحن والفلسفة"، للدكتور سري نسيبة، أستاذ الفلسفة السابق في جامعة بيرزيت، فلسفة جاهزة أو نظرية مطلقة، بل يفتح مساحات معرفية وحواراتية يمكن للقارئ أن يستلهم منها أدوات التفكير النقدي والمنطقي، سواء في التعاطي مع القضايا التعليمية أو العلمية أو السياسية، أو في مواجهة التحديات اليومية والمجتمعية، وخاصة في السياق الفلسطيني الذي يعاني من الاضطرابات والتشتت الفكري.
ويأتي كتاب الدكتور سري نسيبة، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ليقدم للقارئ نهجا فلسفيا متدرجا ومتعدد الأبعاد، لا يكتفي بعرض الأفكار المجردة، بل يسعى إلى تدريب العقل على حسن الحكم ومراجعة المواقف، مستفيدا من التوازن بين الحس والعقل، ومرتكزا على حسن الخلق والتأمل العقلاني.
ويتم ذلك من خلال مشاهد ومداخلات وحوارات افتراضية، ونماذج تتدرج من المدرسة والجامعة إلى اللغة والطبيعة والمنطق، ثم الإنسان والقيم، يتيح الكتاب للقارئ فرصة اكتشاف متعة الفكر الحر وفضيلة التساؤل، وإدراك أهمية النهج الفلسفي كمهارة حياتية، لا مجرد مادة تدرس.
جاء الكتاب في جزأين موزعين على اثني عشر فصلا.
يتناول الجزء الأول موضوع الحس والعقل: إشارات وتنبيهات، ويطرح تساؤلات محورية من قبيل: لمَ الفلسفة؟ وما الحاجة الأساسية إليها؟ كما يعرض فكرة ملكة النفس بوصفها مدخلا للنهج الفلسفي ووسيلة لتجاوز تعطيل العقل.
أما الفصل الثاني، المعنون بمحاور النهج الفلسفي (حسن الخلق والعقل)، فيناقش مفاهيم الوعي والمرونة الذهنية وحسن الخلق، ويضم ملحقا بعنوان نموذج: الحوار السقراطي. في حين يتطرق الفصل الثالث إلى موضوع فوضى الكلام وساحة المدرسة، ويتناول الفصل الرابع اللغة والمعنى من خلال دردشة فلسفية.
ويواصل المؤلف في الفصل الخامس بحثه تحت عنوان إزاحة اللثام: تصنيف المعاني، ثم يخصص الفصل السادس للحديث عن الطبيعي والوضعي، حيث يناقش مفهوم الطبيعة بين ما نعرف وما نفترض، إضافة إلى مقاربة بين المنطق الوضعي والموضوعي.
ويتناول الفصل السابع من الكتاب سؤالا محوريا حول دور اللغة: هل هي مرآة للواقع أم جزء منه؟، كما يعود إلى التساؤل عن أداة اللغة وأسباب ضرورتها. أما الفصلان الثامن والتاسع، فيتطرقان إلى موضوعي الكشّاف السياسي والأخلاقي.
ويضم الجزء الثاني من الكتاب تمارين حوارية؛ حيث يتناول الفصل العاشر قضايا الآلة والإنسان عبر ثلاث محطات: الحصة الأولى، الحصة الثانية، والآلة تتكلم. أما الفصل الحادي عشر، فيفتح باباً على حوار مع العالم الآخر، يجمع بين الرازي وكل من سقراط وأفلاطون وأرسطو. ويُختتم الكتاب بالفصل الثاني عشر الذي يقدم حوارا مع سينوي.
في تمهيده للكتاب، يوضح الدكتور سري نسيبة، أنه يتوجه بهذا العمل إلى جمهور القراء في ميدان التربية، من معلمين ومربين وعاملين في قطاع التعليم، إضافة إلى الأهالي المعنيين، ساعيا من خلاله إلى إبراز أهمية الفلسفة كنهج فكري قادر على استنهاض الفرد وتطوير المجتمع.
تتألف فصول الكتاب من مجموعة مشاهد ومداخلات تهدف مجتمعة إلى إطلاع القارئ على نهج فكري، يمكن الإفادة منه في التعامل مع المسائل والإشكالات التي يواجهها الإنسان في حياته اليومية واهتماماته المختلفة، ولا سيما – كما يرد في بعض الفصول – تلك التي تواجه الفلسطينيين على وجه الخصوص.
ويضيف المؤلف أنه لا يسعى من خلال هذا الكتاب إلى الترويج لنظرية محددة أو تقديم مادة فلسفية بعينها، ولا إلى عرض تاريخ للفلسفة، بقدر ما يهدف إلى فتح صفحات فلسفية ومعرفية متنوعة يمكن للقارئ أن يستخلص منها العبر والدروس حول النهج الفلسفي. ويشير إلى أن القارئ سيجد بين صفحاته شذرات ولمحات من الفلسفة وتاريخها.
نولد مزودين بقدرتين أساسيتين: الحس والتفكير، وغالبًا ما نمزج بينهما سريعا عند تكوين آرائنا ومواقفنا، كلمح البصر، من غير تمحيص عقلي أو خلقي يضمن أن تكون هذه الآراء هي الأفضل أو الأَسلم. يحدث ذلك أحيانا حتى قبل أن نتحقق من معاني المصطلحات التي تعكس هذه الآراء والمواقف. فالنهج الفلسفي ليس مجرد مادة تُقرأ، بل هو مهارة يدرب الإنسان على ممارستها.
ويتساءل المؤلف: هل يمكننا تدريب أبنائنا، وأنفسنا أيضًا، على مراجعة آرائنا وصهر العقل السليم بالخلق السليم؟ وهل نستطيع أن نهتدي إلى سبل ذلك من خلال إضاءات على مشاهد وملاحظات تربوية وعلمية وسياسية، سواء أكانت واقعية أم افتراضية، قد تعيننا على إعادة تنظيم أفكارنا ومداولاتنا؟ ثم يختم قائلا: دعونا نفكر معا في هذا الأمر!. ويشير المؤلف إلى أن ما يفيد عموم الناس في الفلسفة ليس نظرياتها المجردة، بل نهجها الحواري والكشفي أو الاستقصائي، القائم على التروي في فحص الرأي والرأي المخالف، بالعودة إلى التعليل العقلي والأخلاقي قبل إصدار الأحكام. ومن جهة أخرى، يرى ما يحتاجه المجتمع الفلسطيني.
وفي خضم ما اعترى واقعه ويعتريه من عواصف، هو تحديدًا ذلك الفضاء الفكري والنفسي الهادئ الذي يتيح تبادل الرأي الصادق حول الحاضر والمستقبل، بحثا عن أفضل المسارات لتحقيق الخير العام.
وخلص المؤلف، إلى أنه ويتوقع أن يلمس القارئ من خلال هذه النماذج أن التباين في الرأي قد يطال أكثر المواضيع دقة، وأن الملاذ الأفضل للتعامل مع هذا التباين يكمن في اتباع النهج الفلسفي المذكور، مهما كان الموضوع محلا للنقاش.
في خاتمة هذه الدراسة، يبين المؤلف، أن الفلسفة يمكن أن ينظر إليها تارة كمدرسة معرفية أو نظرية مكتملة، وتارة أخرى كنهج في التفكير يعد أدق الوسائل لمعاينة موضوعات المعرفة المفترضة والحكم بشأنها. وما سعى هذا الكتاب إلى إظهاره هو فوائد هذا النهج في مختلف الحقول الحياتية والمعرفية، ومبادئه الأساسية التي تتلخص في حسن الخلق والعقل.
ويؤكد أن النهج ليس مادة ندرسها فحسب، بل هو مهارة نصقلها بالتدريب والممارسة. فتربية النشئ على هذا النهج منذ طفولته، ومواصلة تدريبه عليه خلال رحلته التعليمية، لا يساهم فقط في تمتين النسيج المجتمعي وحمايته، بل يتيح أيضًا إطلاق مواهبه الذاتية.
ويشير إلى أن الحسم الأكثر نفعا في أي خلاف، سواء بين العلماء حول معنى الجاذبية – قوة أم تجويف في بعد فضائي، أو بين السياسيين حول المصلحة الوطنية، مفاوضات أم مقاومة مسلحة، لا يتحقق إلا بالجمع بين حسن الخلق والعقل.
ويشير نسيبة إلى أن ما دفعه لنشر هذه الأفكار، هو حالة التوتر النفسي التي لاحظ انتشارها في المجتمع بفعل الاحتلال، التي رافقها تشتت في الآراء وتعصب لها، وانسداد العقول عن مساحات الرؤية الأوسع.
وبالرغم من تقديم المادة كنهج وليس كنظرية واحدة على حساب أخرى، فإن القارئ، وخصوصًا مع آخر فصول الكتاب، قد يتلمس طرحا فلسفيا محددا مفاده بأن الإنسان صاحب إرادة ومسؤول عن أفعاله، وأن معيار هذه الأفعال يرتكز أساسا على الصفات التي يتحلى بها فعليا، حيث إن القيم الأخلاقية بطبيعتها نظرية ووضعية.
ويضيف المؤلف أن هذا المنظار يعطي أهمية للتربية، وحسن الخلق والعقل، ودور الإنسان في تصميم حياته. ويقول المؤلف "إن الكتاب لا يقدم جديدًا في الفلسفة نفسها، بل ركز اهتمامه على تبيين أهمية النهج الفلسفي في مختلف مطالعاتنا، سواء أكانت تعليمية أو علمية، أو في حياتنا السياسية".
ورغم أن الأفكار المطروحة هي نفسها منذ بداية الكتاب، فقد حرص على عرضها بأسلوب متدرج، بدءا من مشاهد مدرسية وجامعية، مرورًا باللغة والطبيعة والمنطق، وانتهاءً بالإنسان والقيم.
يختتم الكتاب فصوله بحوار متخيل، قد يبدو شائكا بعض الشيء، بين فيلسوفين من عصرين وخلفيتين مختلفتين، حول موضوع حرية الإرادة والآجال. ويبرز في هذا الحوار خيط يربطنا مجددًا بالتساؤلات المتعلقة باللغة والذرة، وقد تم تضمينه بهدف التعرف على نموذج لطبيعة الحوار المهني الفلسفي.
ويشير المؤلف إلى أن الأفكار المطروحة في هذا الكتاب ارتكزت على ما التقطه أو استشفه من قراءاته وتجربته المهنية والحياتية على مر العقود. ولم يكن الهدف منها الإتيان بما هو جديد، بل، كما ذكر في المقدمة، كان القصد استثارة الاهتمام بتضمين النهج الفلسفي في برامجنا التعليمية.
وعلى الرغم من أن الكتاب ليس بحثا علميا أو مادة تعليمية، إلا أن الإشارات العينية في نصه إلى بعض الكتب والمقالات والنظريات تستدعي ذكرها في قائمة المراجع لمن يرغب في تعقب قضية أثارت اهتمامه الخاص. ويمكن بالتالي اعتبار قائمة المراجع المرفقة وملاحظاتها، تقديما عاما وموجزا لبعض الأدبيات المذكورة.
وخلص نسيبة إلى أنه حول الجواب أخيرا على السؤال الذي طُرح في أول الكتاب حول مهنة الفيلسوف، فيمكن القول إن موضوع علمه هو الأفكار المتعلقة بالكون واللغة المستعملة للتعبير عنها، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه اللغة هي أيضًا جزء من الكون الذي يفكر فيه ويتم تحليل ألغازه.
