عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
رواية أنا يوسف يا أبي لباسم الزعبي.. رؤية جديدة لظاهرة الإرهاب
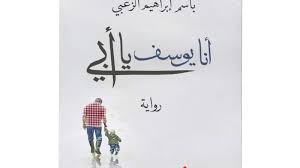
الدستور-إبراهيم خليل
استأثر موضوع الإرهاب، والجهاديين، باهتمام الراوئيين في العقدين الأخيرين. فمن أقدم الروايات التي سلطت الضوء على هذا الموضوع المؤلم رواية « سيقان ملتوية» لزينب حفني 2007 ورواية «ذاكرة الماء» للجزائري واسيني الأعرج (2008) و» رغبات ذاك الخريف» لليلى الأطرش 2010 ورواية «الإرهابي» للروائي عبد الله ثابت 2010 ورواية «سأرى بعينيك يا حبيبي» لرشاد أبو شاور 2012 . و»سماء قريبة من بيتننا» للروائية السورية شهلا العجيلي(2015) و»مياه متصحّرة» لحازم كمال الدين 2015 ورواية «موسم الحوريات» لجمال ناجي 2015 ورواية «خبز وشاي» لأحمد فارس الطراونة 2016 ورواية «ذاكرة الظل» للتونسية فتيحة بن فرج 2017 و» البحار « لهاشم غرايبة 2017 و»فرانكشتاين في بغداد» لأحمد سعداوي 2018 .
تبايُن الرؤى
وقد تباينت في هذه الروايات مواقف الكتاب، ورؤاهم، لهذا الوباء الذي لا ريب في أن أصابع الصهيونية العالمية، وليس الإسرائيلية فحسب، هي التي تواصل من وراء الستائر تحريك هذه المنظمات التي تدعي الإسلام، وتعلن حربها على المسلمين قبل غيرهم، مثلما جاء في بعض ما يجري من حوار بين يوسف عون واسمه الحقيقي محمد عون، قبل أن يتحول من شاب غير جهادي مشغول بإنقاذ والده عون مما آل إليه من يأس، وإحباط، نتيجة استبعاده من عمله،وإحالته إلى الضمان في وقت مبكر، لكونه يأبى السكوت، والصمت، على ما يراه من فساد ينخر المؤسسة الإدارية، والمالية، في بلاده الأردن، فيقرر الرحيل ومغادرة الوطن إلى موسكو، التي نجح في نهاية الأمر بالعثور فيها على عمل مع صديقه الروسي فاديم، وهو صديق كان قد تعرف عليه في رستوف، تلك التي قضى فيها ستا من السنوات أثناء الدراسة، فربطت بينهما عرى الصداقة المتينة. سواء في المرحلة المعروفة بزمن الاتحاد السوفياتي، أو بعد نشوء روسيا الاتحادية التي تسيطر عليها المافيات في رأي الصديق القديم المتجدد فاديم، فهو لا يفتأ ينتقدها، وينتقد بقسوة النظام الرأسمالي، فكأنه بهذا يؤكد أنه آخر الشيوعيين(انظر ص 126- 127).
استعادة الماضي
والمؤلف الزعبي يعود من حين لآخر بقارئة القهقرى إلى الماضي، فيروي من البداية كيف حضر عون - والد محمد وريمة – شابا عازبا إلى روسيا للدراسة، وكيف تعرف على الحسناء الروسية غالينا، وكيف تحولت المعرفة في وقت قصير إلى حب لا يخلو من لهو، ومن عبث، ثم إلى زواج بقسيمة شرعية. ويتصل بهذا الموضوع المسترجع، على سبيل التذكر الذي ورد في الرواية بلسان الراوي، لا بلسان عون نفسه، موضوع عودة الأسرة: عون، والطفلين والزوجة الروسية، التي لم يرض عنها لا الأب، ولا الأم، ولا الأهلون.. وما جرى من تغيير في حياته الشخصية وحياتها، وما طرأ أيضا من تغيير في حياة الصبيَّيْن، فريمة زوجت وسافرت مع زوجها يحيى لإحدى دول الخليج؛ قطر، ومحمد يتابع الدراسة. وفي الأثناء يفقد عون عمله الذي يعتاش منه، فتنصحه غالينا بمغادرة الأردن إلى روسيا.
في المطار
ولهذا تبدأ الحكاية الروائية من اللحظات التي تنتظر فيها هي ومحمد كلاهما عونا في قاعة انتظار المغادرين، بيد أنه يتأخر لقضاء واجبات عدة منها وداع الأحبة، وقد طال بسبب المفاجأة التي لقيها في منزل عائشة، أي مقابلة جميلة التي كانت قد اقْتُرحَتْ خطيبةً له وزوجه قبل أن يغادر إلى روسيا وقبل أن يتعرف على غالينا. وأخيرا التحق عون بهما وكانوا جميعًا في الطائرة، ولم يلتقوا ببعض إلا عند توزيع العصائر، والأطعمة.
موت بطيء
في روسيا لاحظ محمد بن عون على أبيه أنه يائس، ويشعر بالوحدة، والعزوف عن غالينا فهما يعيشان تحت سقف واحد وفي شقة واحدة وكأنهما منفصلان. ووالده لا يعمل، ولا يتصل بأحد، ولا يستخدم النت، ولا يرى نشرة أخبار واحدة، وهو الذي كان لا يفتأُ يتابع نشرات الأخبار في جلّ القنوات، وقلما ينظر في الهاتف.. وفوق هذا كله لا ينفك يتناول الفودكا. فهو باختصار كالذي يموت موتا بطيئا. وقد صرح بهذا في الحديث مع الابن غير مرة. وكان ابنه يشك في أن غالينا- أمه- تخون أباه، وأن لها علاقة بأحد الروس، وأنها بعد أن افتتحت متجرًا للألبسة، والزينة النسائية، اتخذته شريكا في رأس المال للتغطية عن علاقتها به. وقد سلطت غالينا على محمد واحدة من الموظفات(إيرينا) لغايتين؛ الأولى هي إفساده، والثانية معرفة أقصى ما يمكن عن نشاطه الرقابي عليها، وعلى عشيقها فولوديا، فهي رقابة تخشى أن تسبب لهما مشكلات مع عون.
وبعد أن تحسنت أحوال عون في عمله الجديد مع فاديم، وبعد أن كشفت إيرينا عن حقيقتها لمحمد في اللقاء الذي عرضت عليه استخدام الواقي الذكري، اختفى الشاب فجأةً مما أصاب والده بالرعب (انظر ص 132- 133). فهُرعَ للاتصال بفاديم لعله يعرف عن طريق اللاب المشفّر استخراج ما يفضي لتحديد مكانه. اكتشف هذا الحاذق بالأمن السيبراني أن محمدا كان على اتصال بواحد تركي، أو سوري مقيم في تركيا(حمزة) في اسطمبول وأن المنشورات المتكررة على موقعيهما تشير لاتفاق بينهما على انضمام محمد للجهاديين في سوريا، وأن هذه هي رغبته من سنين(انظر، ص 114 وص132 وص 139). وفي الفصول التالية جميعها ينسى الراوي، أو يتناسى بكلمة أدقّ، موضوع عون وغالينا وإيرينا وسحر وفاديم والفودكا وفولوديا، وينصب التركيز في ما تبقى من مرويات الكاتب على مجريات وقعت في غازي عنتاب، وفي أم الجوز، وفي جرابلس،وفي الرقة، وفي غيرها من أمكنة في سوريا. لكن القشة التي قصمت ظهر البعير - مثلما يقولون - هي الغارة التي أودت بحياة عدد غير قليل من الجهاديين، في مقدمتهم محسن النوري الذي ينادونه باسم (أبو عكرمة) على عادة الجهاديين في استخدام أسماء حركية مستعارة احترازا. وكان هذا المحسن أميرًا على ثلاث من القرى الواقعة في محيط الرقة، وتحت إمرته ثلاثة عشر عنصرا من عناصر التنظيم الجهادي، وهم خليط من المصري أبي عمرو، والتونسي همام، وبعض الأجانب، والسوريين(ص167) وله مساعد ينادونه بكنية مستعارة هي (أبو بكر).
وهذا حافزٌ جديد يوقظ في الراوي العليم الرغبة الشديدة في متابعة المجريات، فقد كان أبو عكرمة هذا قد تزوج من (مُهْرة) التي لم يتجاوز عمرها التاسعة عشرة. وعلى ذمة الراوي البصير بالنساء، تعد هذه الفتاة نموذجا للمرأة التي تستحق الزواج جمالا، وقوةَ شخصية، وتربيةً أخلاقيّةً. ووَصْفُ الراوي لخطبتها من أبيها مشهدٌ ساخرٌ يوحي بغلاظة أبي عكرمة الذي شوهد وهو يقتل رجلا مسنا أصمّ يبحث عن طعامه في حاويات القمامة، فقد صمّمَ على أخذ الفتاة عنوة لو أن الأب الوليّ لم يوافق بإذعان(انظر ص 169). وهذا موقف يتكرر تقريبا في معظم الروايات التي عرضت لموضوع الإرهاب. فالجهاديون ينظرون للزوجة، لا على أنها إنسان، بل غنيمة حرب، وهذه الغنيمة لا يتكبدها الأعداء مثلما يُفترض، وإنما الأهل، والأنصار، ممن يدعي الجهاديون أنهم يدافعون عنهم، وعن مصالحهم، وعما تبقى لديهم من دين.
إلى جرابلس
بعد مقتل الرجل (أبو عكرمة) وجد محمد الذي- يعرف في هذا الوسط باسم يوسف عون - نفسه مضطرا للعناية بمهرة أرملة الشهيد، ولا سيما بعد الغارة التي تعرضت لها قرية أم الجوز، وأودت بعشرة على الأقل من أهل مُهْرة. ولم يجد الاثنان، مهرة ومحمد، بدا من الذهاب إلى جرابلس(انظر ص 206- 2014). وساعدهما على الوصول سائق شاحنة كان هو الآخر في طريقه إليها بزوجته، وأطفاله، وأمتعته، وأثاثه، لمكان يوصف بمكان اللجوء. بعد مساومة مع المهربين تمكن الاثنان من الوصول إلى اسطمبول، ووجد كل منهما عملا، وابتدأت حياتهما من جديد بصفة زوجين على سنة الله ورسوله، لكنّ الزوج في القسيمة انتحل صفة الزوج السابق وهويته. وبهذا بدأت المتاعب التي لا تنتهي، والألم الذي يقاسي منه كل منهما يزداد يومًا بعد يوم.
إيقاع سريع
في الصفحات الثلاثين الأخيرة تتلاحق المجريات بسرعة، وتتراكم بطريقة مغايرة لإيقاع الرواية البطيء المغرق في التفاصيل الضرورية، وغير الضرورية، فكأنّ المؤلف أراد أن ينتهي من الرواية بعد أن أعيته المتواليات السردية المطولة في نحو 215 ص.
فقد اكتشفت ريمة التي تعيش مع زوجها يحيى، وابنتها ذات السنوات الثلاث في الدوحة، عن طريق الكوابيس، أن والدها عون في وضع صحي خَطِر(ص222) . وبدأت تتصل على رقم الهاتف تارة وعلى المسنجر تارة. وتتصل على رقم أخيها محمد، ولكنها لم تتلق ردودا مما زيدَ في قلقها، وضاعف من خوفها، واخذت تهاتف عمها صالح، وفي النهاية استطاعت التواصل، وتحقق لها بعض الاطمئنان، لا كله، إلا أن محمدا لم تستطع أن تعرف شيئا عنه، لا كثيرًا ولا قليلا. وفي سرعة تبين أن للمختفي موقعا على (الفيس بوك) لكن باسم يوسف، وفيه منشورات تؤكد أنه هو محمد لكنه يوسف أيضًا. فقد اضطر ليعيش في اسطمبول بهوية يوسف الذي تزوج امرأة محسن النوري الذي قتل في الغارة المذكورة على أم الجوز. وبطريقة لا تخلو من تعقيد بدأ الأب يخاطب ابنه بآيات قرآنية عن يوسف والجبّ، وعن الصلة بينه وبين يعقوب(ص229). وفي المشهد الأخير كتب محمد على صفحته مخاطبا أباه عونا (أنا يوسف يا أبي). فهذه إشارة لعلاقة المرويات بالعنوان سبقتها إشارةٌ أخرى من ريمة التي تعبر فيها عن إعجابها بصوت مارسيل خليفة وهو يتغني بقصيدة درويش(ص224).
اختلاف
يُلاحظ أنّ هذه الرواية تختلف عن سائر الروايات التي ُذكرت في مستهل هذه القراءة من حيث رؤية الكاتب لموضوع الإرهاب، فالكاتبُ لم يتوقف عند جزئية فيه، مثلما هي الحال لدى كل من العجيلي في سماء قريبة من بيتنا2015، أو حيدر حيدر(1) في روايته مفقود (2011)، أو جمال ناجي في موسم الحوريات2015، ولكنه يدلف بنا إلى فضاء الأحداث بقوة، فلا يغرُب عن ذهنه شيء من التفاصيل التي لا يتنبه إليها إلا من كانت لديه المعرفة بحوادث معينة، ووقائع جرت على الأرض، وفي متابعة تفصيلية دقيقة. وهذا شيءٌ يُحمد للرواية. ولكن المؤلف استخدم طريقة في السرد هيمن فيها الراوي العليم على (الحكي) هيمنة مطلقة، فهو يتحدث عن عون، أو عن غالينا،التي توفاها الله في قصفٍ مفاجئ بدونتسيك، أو عن محمد، أو ريمة، أو إيرينا، أو فاديم بنفسه، ونادرًا ما يسمح لهؤلاء بالحديث عن ذكرياتهم، وعما قاموا به من أفعال بأنفسهم، أو يتيح لهم أن يعبروا عن رؤاهم، وافكارهم، بأفعالهم، مما يعرف فنيا بالتشخيص عن طريق الأفعال، مما طبع الرواية بالطابع التقليدي، أو شبه التقليدي.
هيمنة الراوي
فعلى سبيل المثال: حكاية تعرُّف عون على غالينا، فالمتوقع أن ترد على هيئة تداعيات يتذكرها لا عن طريق محكيات الراوي. وهذا اقتباس يوضح لنا طريقة المؤلف في اعتماد الراوي العليم في التذكير بما تمر بها الشخصية الروائية(ص 156)» أما عون، فراح يستعيد شريط حياته.. ها هو ذا يفقد كل شيء. هل كان قدره أن يتزوج من تلك الفتاة الروسية دون أن يربط بينهما أي رابط غير الرغبة؟ ثم تنجب له طفلين لم يمنحاهما الحب الكافي إلخ..) فالأوْلى بالكاتب والأجدر أن يستغني عن قوله فراح يستعيد.. موحيا بأن هذا الذي يتذكره يتذكره فعلا في تلك اللحظة التي يمر بها. وهذا أيضًا يمكن أن يُتُّبع في تفسيره لما وقع، وأدى إلى فصله من العمل، بدلا من أن يقول الراوي بعض ما يقوله عن هذا الإجراء. وشيءٌ آخر يطبع الرواية بالطابع التقليدي، فقد تخللتها فقرات طويلة يتحدث فيها الرواي عن الحروب، وعن الفساد، وعن التناقض الذي نعاني منه بين المذاهب والتيارات، فلو أنه اتخذ من طريقة فاديم على سبيل المثال في انتقاده للوضع الروسي الآن، لكان أكثر صدقا، وأجدر من الخطب في إقناع القارئ بمصداقية وجهة النظر. ففي الفقرة الآتية على سبيل المثال يتساءل محمد: «هو يعرف أنه جاء إلى سوريا ليس بهدف القتال مع أحد دون آخر، لكنه جاءَ هربًا من أسرته التي كانت تتفكك أمام عينيه.. ربما كان يرى أن حياته انتهت ولم تعد لها قيمة. لذلك جاء هنا ليجعل لها قيمة « (ص 183) فابتداءُ الكاتب للفقرة بالضمير هو يُعرف منه عزو الكلام للراوي بدلا من أن يكون التساؤل لمحمد أو (يوسف) نفسه. وهذا يُضعف ما يقترب به المؤلف من تقنية التداعي، أو المونولوج الداخلي.
خاتمة الرواية
وقد ابتدع الكاتب في روايته خاتمة، وأضافها بهذا العنوان، كالخاتمة التي تضاف للكتاب، أو البحث، أو الأطاريح الجامعية لنيل الماجستير، أو الدكتوراه. والذي نعرفه أن الخاتمة أو النهاية في الروايات تستخلص، وتُتَبيَّن، من سيرورة الحوادث، ولا تكتب منفصلة. فهذا يعد من وجهة نظر الكثير من الدارسين تدخلا في استجابة القارئ، وكأنّ المؤلف يقول للقارئ: لا تتعب نفسك، فهذا هو ما أردت أن أقوله في هذه الحكاية، ومما يذكر أن رواية (ذات) لصنع الله إبراهيم، كغيرها من رواياته، لا ينهيها الكاتب بنهاية ما، بل ترك للقراء أن يتخيلوا تلك النهاية.
ولا تفوتنا الإشارة لما يشعر به بعض القراء من عدم التناسب بين موضوع الرواية، وهو الإرهاب، والعدول عن الإرهاب، وحكاية يوسف بن يعقوب. فقد يرَوْن فيه ضربًا من الافتعال، عدا عن أن قصيدة درويش (أنا يوسفٌ يا أبي) تقوم على فكرة بعيدة جدا عما هو مطروح في الرواية، وهي فكرة لا تحتاج منا لتوضيح ما هو واضح، فحكاية إخوة يوسف تردَّد توظيفها في عشرات القصائد لمحمد القيسي، ومريد البرغوثي، وخالد أبو خالد، وصلاح عبد الصبور، وآخرين لا متسع لاستقصائهم، وذكر عناوين قصائدهم، وجلها توحي مباشرة، وبلا مواربة، لتآمر الأشقاء على الشقيق، وخذلانهم له، وأين الرواية من هذا؟
فصول وعناوين
علاوة على هذا كله تخيَّر المؤلف لفصول الرواية عناوين ملائمة، وأخرى غير ملائمة، فأحدها مثلا بعنوان موت عون(ص86) والحال أن الفصل لا علاقة له بالموت، وإنما بإدمانه على احتساء الفودكا كفلاح روسي(موجيك) مدمن. وعنوان آخر « قنبلة موقوتة» وفيه يسخر من الحفل الذي أقامته غالينا، بيد أن لهذه السخرية أثرها العكسي. فالرواية عن الإرهاب،والحروب، وقد يظن القارئ - مثلما ظننتُ - أن في الأمر قنبلة حقيقيّة. وأحدها بعنوان « فكرة الزواج « وهو عنوان يدعو القارئ للذهاب بعيدا، كأنْ يتوقع حديث المؤلف عن الزواج وأهميته في استمرار النوع البشري، وموقعه في الشرائع والقوانين، ومدونة الحالة المدنية. هذا مع أن العناوين جلها لم تكن ضرورية قطعًا، ولو استبدلها بأرقام متسلسلة مثلا لما فقدت الرواية شيئا من نمطها السردي، وتتابع الحوادث فيها، وهو تتابع خطي موافق لدورة عقارب الساعة لا غير، فضلا عن أن الفصول قصيرة جدًا، وكان من الخير للكاتب دمج الكثير منها بعضها ببعض. وقد أضاع الكاتب فرصة ذهبية كانت بين يديه، وهي تسليط الضوء على العلاقة السردية بين الأنا والآخر، إلا أن التبئيرFocalization انصبَّ على شخصية محمد، أو يوسف بن عون، وأجواء الرقة، وأم الجوز، وجرابلس، والمعابر، وحمزة، وأبي عكرمة، ومهرة، إلخ.. مما دفع بموضوع الآخر إلى الظل، فبدا ثانويا لا يمكن اتخاذه موضوعا لدراسة الآخر مع كثرة الإشارات لتأثير المكان الروسي، والثقافة الروسية، على الشخوص.
