عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
السرد التناوبي وتعدد الأصوات في رواية «قربان آل يونس» لأحمد خيري العمري
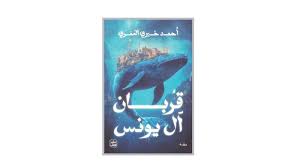
الدستور-هازار محمد الدبايبة
تنعتقُ السردياتُ العربيةُ اليوم -في معظمها- من البنية الدرامية الكلاسيكية، ذات النمط التقليدي، أُحادي الصوت والمنظور واللغة؛ حيث صار البعضُ يراه نمطًا ديكتاتوريًّا؛ يُخضِعُ الشخصياتِ والأحداثَ لموقفٍ أيديولوجي جاهز، ويصيِّرُها جميعًا لخدمته بشكلٍ أو بآخر، عبر ساردِه الأوحد، المهيمنِ على جوِّ الحكاية؛ لذا صارت الرواية البوليفونية (متعددة الأصوات) أكثر رواجًا وقَبولًا في عصرنا الحالي، المُتسمِ بالتنوع والتعقيد، وتعدُّدِ الهُويات والأفكار والرؤى، فلم يَعدْ من السهل توجيه القارئ لتبني موقفٍ ما، أو فرض فكرة ما عليه.
وتُعَدُ رواية «قربان آل يونس» لأحمد خيري العمري، الصادرة حديثا عن دار «عصير الكتب» إحدى السرديات المنسجمة مع هذا التوجُّهِ إلى التعددية، والمعرفة الاحتمالية، بعيدًا عن المنطق اليقيني، والمنظور الأُحادي.
ويعتمدُ الكاتبُ لتحقيقِ هذه الرؤيةِ السردية خطوطًا زمنية متعددة، لا تنتمي إلى الحكايةِ الرئيسةِ فحسب، بل تتعداها إلى حكاياتٍ فَرعية، تُساهم في فَهمِ الأحداث، وتفسيرِ الواقع. فرَّقَتْها عصورُها المتباعدة -التي تصل إلى ما قبل الميلاد- وجمعتْها هُويةٌ مكانيةٌ واحدة، تتجاوزُ ماديةَ المكانِ الملموس إلى معانٍ نفسيةٍ عميقة، بالغة الرمزية؛ فقد صارت الموصل (نينوى) -فضلًا عن كونها عاملًا مشتركًا بين المَحكيات- هدفًا في ذاتِها، يسعى العملُ لبلورتِه، وتأكيدِ قيمتِه التاريخية والحضارية والإنسانية.
وأوَّلُ هذه الخطوط الزمنية ظهورًا، وأكثرها قوةً (الزمن الحاضر)، الذي خضعتْ له أحداثُ السردِ الأساسي، واعتمد فيه الكاتب التسلسلَ الدرامي المنطقي؛ فظهرَ متصلًا متتابعًا، لم يقطعْ جريانَه إلا بعضُ مشاهدِ الذاكرة (الفلاش باك) على ألسنة الشخصيات؛ فقد استندَ هذا الخط إلى الرؤية السردية المُصاحبة، واعتمد على عددٍ كبير من السُّرّاد، الذين تناوبوا على بناءِ الحدثِ القَصصي، كلٌّ عبر منظورِه الشخصي، ووفقًا لزاويةِ رؤيته؛ ابتداءً من البطل (صهيب): المهندس المعماري من أصلٍ موصلي، الذي فاز تصميمُه في مسابقةٍ لإعادةِ إعمار مسجد النبي يونس في الموصل، وانتقالًا إلى شخصياتٍ شاركته هذه البطولة بشكلٍ أو بآخر؛ فكانت شخصيات مركبة، تميَّزتْ بتعقيدِ بنائِها النفسي، وتطوره المستمر (يحيى، سَفانة، ليليان، مهند، عادلة، فائزة). وقد عملتْ رواية القصة على أكثر من لسان، وحسب قناعاتٍ مختلفة على فتحِ أبوابِ التأويل بالنسبةِ للقارئ، ومكَّنَتْه من دراسةِ الأحداث، وإصدارِ أحكامِه الخاصة على أصحابِ الصراع بحريةٍ تامة، دون أنْ يمارسَ العملُ أيَّ نوعٍ من الوصاية أو الاحتكار الأيديولوجي؛ فالشخصيات تمتلكُ وعيًا مستقلًّا، يعبِّرُ عن كينونتِها وهويتها، وتختلف في منظوراتِها الاجتماعية والحزبية والطائفية. كما أنَّ تنوُّعَ السُّرّادِ يسمحُ للقارئ أنْ يحلِّلَ المواقفَ من وجهتي النظر الذكورية والأُنثوية، مما يمنحُ العملَ مزيدًا من الواقعية والانفتاح.
ينطلقُ السردُ من لحظةِ وصول (صهيب) إلى الموصل لتقديم تصميمه، والتعرُّفِ إلى عائلته التي لم يرَها قط، وتستمرُّ الأحداثُ في التطوُّرِ والتأزُّم عبر حَبكةٍ تصاعدية، ذات إيقاعٍ بطيءٍ نوعًا ما، يخدِمُ توجُّهَ الرواية السياسي والتاريخي. وبتكشُّفِ الحقائقِ تباعًا أمام أفراد العائلة تصلُ الأحداثُ إلى ذروتها، المتمثلة بنبشٍ قبرٍ وإخراجِ جُثة «وسمعتُ صوتًا يشبه صوتي وهو يقول: هناك جثة، بقايا جثة، هيكل عظمي». لتهبطَ الأحداثُ تدريجيًّا إلى نهايتِها التي أكَّدها خطابٌ فلسفيٌّ عميق على لسان البطل؛ حيث يشبِّه كلَّ الصراعات والأزمات التي شكَّلتْ ملامحَ الموصل الجديدة بحيتانٍ يبتلعُ بعضُها بعضًا، غاصَ في تفاصيلها، وخاض غِمارَها مجبورًا في أوَّلِ الأمر، ثم مُخدَّرًا برغبةٍ غريزية في التماهي مع هذه المدينة التي ظلَّتْ قابعةً في داخله، حتى قبل أنْ يعرفَها؛ فمِن حُوت التاريخِ البعيد لنينوى، وذاكرتها الحية الخالدة، إلى حُوتِ الطبقات الاجتماعية التي شكَّلتْ نفسية المجتمع وهويته الحالية، وصولًا إلى الجرائم الفظيعة التي ارتكبتْها تنظيماتٌ إرهابية باسم الدين في فترة ما، فلم تجدْ مَن يردعُها؛ لضَعف أجهزة الدولة آنذاك، وعجزها عن مواجهة هذه العصابات التي انتشرت كالطاعون في المنطقة من جهة، وما كانت تعانيه هذه الأجهزة من فسادٍ إداري، وتواطُؤٍ مع تلك الجماعات من جهةٍ أخرى.. «يتغير المحافظ ووزير العدل والسلطة الحاكمة بأكملها، وأبو نادية يبقى يلعب على كلِّ الحبال؛ يأخذ من الخصوم جميعًا بحيث يكون هو الرابح الأكبر». وقد قادَ هذا الحُوتُ بطلَنا إلى حُوتٍ أشد قوة وتأثيرًا (حُوتِ العائلة)، بأسرارها وسراديبها العميقة، التي ما كان ليعرف عنها شيئًا لو بقيَ في أميركا ينظرُ إلى الموصلِ بعينِ مستشرقٍ يريدُ فرضَ رؤيته الغربية، التي يؤمنُ بتفوُّقِها واستحقاقها، وصلاحيتها لكلِّ زمانٍ ومكان.. وقد أوصلتْه هذه الرحلةُ أخيرًا إلى حُوتِها الأصغرِ الأكبر؛ الحوت الذي أعاده إلى نفسه.. «كما لو لم يكن من الممكن الوصول إلى نفسي دون المرور بكلِّ الحيتان الأخرى».
وتظهر براعةُ الكاتب في قدرتِه على نقلِ ثقافةِ المجتمعِ الموصلي، بعاداتِه، وموروثاته الشعبية، وخصوصيته اللغوية، دون تكلُّف؛ فهو لا يحاولُ إقحامَها داخل النص، بل يذيبُها بسلاسةٍ مع باقي مكوناتِه، لخَلقِ تجربةٍ سرديةٍ متماسكة. ولأنَّ العملَ يقومُ على أساسٍ سياسيٍ تاريخي، فقد ركَّزَ اهتمامه، ووجَّهَ بوصلتَه إلى الأماكنِ التراثية والدينية، واحتفى بها بشكلٍ خاص؛ فأصبح المكانُ بحضورِه القوي مرآةً، يرصدُ العملُ من خلالها همومَ هذا المجتمع، ويناقشُ التغيراتِ الفكريةَ والإنسانيةَ التي شهدها، وصارتْ جزءًا من ذاكرته الجمعية، ونسيجه الاجتماعي. «مررنا على جسر دجلة، قال سفانة إن اسمه الجسر العتيق.. تذكرتُ ما قالته أليكسا من أنَّ النبي جرجيس ذري جثمانه في دجلة، تراه أخذ جزءًا من هيبته من جرجيس؟»، «فقط شعور بالامتداد نحو المكان، الامتداد نحو المكان والتداخل معه».
وينتقلُ السرد -معتنقًا الرؤيةَ المصاحبة الأولى- إلى مستوىً زمنيٍّ جديد، يعود إلى القرنِ الثامنِ قبل الميلاد؛ تناولَ فيه قصة النبي يونس -عليه السلام- فظهر كشخصية روائية، تروي حكايتَها مع أهلِ نينوى، وفي بطن الحوت، دون تدخُّلٍ سرديٍّ خارجي. وقد قوّى هذا الخطُّ الطابعَ الديني للعمل، وغذّى الصبغةَ الإيمانيةَ فيه، وأضفى على الحَبكةِ مزيدًا من العمقِ والتعقيد، كما ظهر ارتباطُه جليًّا مع السرد الرئيس. إلا أنَّ استعمالَ الرؤية الداخلية لنقلِ أحداثِ القصة على لسان يونس بن متى -عليه السلام- جعلَ الكاتبَ يتجاوزُ القصةَ الأصليةَ الثابتة إلى كثيرٍ من المواقفِ والحواراتِ الداخلية والخارجية المُتخيَّلة، لتناسبَ جوَّ المحكية، وبناءَها السردي، والتي قد يراها البعض غريبة ومستهجنة.. «لم أسرق، لم أكذب، على الأقل لا أذكرُ أني كذبت». وتُظهِرُ قصةُ العملِ أنَّ يونس -عليه السلام- لم يصل نينوى، بل هربَ منها في أوَّل رحلة بحرية رآها -بعد أنْ أوحى الله تعالى إليه- خوفًا من جبروت وعناد أهلها، وبعدهم عن الحق. وفي هذا مخالفةٌ واضحة للقصةِ الثابتة التي تقول أنَّ يونس بن متى وصل فعلًا إلى نينوى، ودعا أهلَها إلى الله -عزَّ وجل- فكذَّبوه، وتمردوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك من أمرهم خرج من بين أظهرهم، ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث.. إلى آخرِ القصةِ المعروفة.
ولا يكتفي السرد بهذين الخطين الزمنيين، بل يتعداهما إلى خطين آخرين، ينتمي أحدُهما إلى بداياتِ عهد النبوة، أي إلى القرن السابع الميلادي؛ حيث يجمع فيه العملُ شخصيتين من أهل نينوى: الأولى هي شخصية الصحابي الجليل صهيب بن سنان، المعروف بصهيب الرومي، وهو أحد كبار الصحابة البدريين، أما الثانية فتعود لعدَّاس (الغلام النصراني لابني ربيعة في الطائف). سلَّمَهما الكاتبُ دفةَ السرد؛ فروى صهيب -رضي الله عنه- قصة سبيه من نينوى، وأخذِه عبدًا للروم، حتى وصولِه إلى مكة، ليستعيدَ فيها حُريَّتَه ويعلنَ إسلامَه، أما عدَّاس فروى حكايتَه الشهيرة مع رسولنا الكريم -عليه أفضلُ الصلاة وأتمُّ التسليم- «شعرتُ أنَّ كلمة نينوى قد زادت النور المنبعث من وجهه، سمعته يقول: (من قرية الرجل الصالح يونس بن متى)». ولا يتخلى السرد عن رؤيته المُصاحبة إلا في الخط الزمني الأخير، وهو خطٌّ خجولٌ جدًّا، يكاد يكون لقطة مقتطعة من حياةِ إحدى الشخصيات الغائبة الحاضرة (يونس باشا)، في عشرينات القرن الماضي؛ تنتقل فيه زاوية الرؤية من الداخل إلى الخارج، فيراقبُ الساردُ الأحداثَ من بعيد، ليُسجِّل مشهدًا لخَّصَ حالَ الموصلِ في تلك الفترة المتوترة، غير المستقرَّة، بعد انتهاء حُكم الدولة العثمانية.
إنَّ تعدُّدَ الطبقات والمستويات الزمنية أعطى الكاتبَ مِساحةً كبيرة ليتناولَ الموصل من جميعِ جوانبها (التاريخية، والاجتماعية، والقومية)، ويجعلَها مركَزًا، وبؤرةً جامعة لمختلف الأفكارِ والمشاعرِ الإنسانية والتوجهات الأيديولوجية؛ مما يتركُ القارئَ في دوامة من التساؤلاتِ والتأملات، دون أنْ تقدِّمَ له الروايةُ إجاباتٍ تلقينية جاهزة، بل توكلُ له مَهمة جمعِ الخيوط، وفَهمِ الصِلات، وترتيبِ الإشاراتِ الزمنية والمكانية؛ لتكوينِ صورةٍ متجانسة، واضحة الملامح.
