عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
ملامح واقعية وانطباعية في رواية البحر الأسود المتوسط
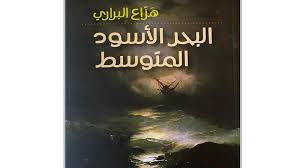
الدستور-نور فيصل بني عطا
يعد المذهب الواقعي الخيار الأقرب والأسلم للمبدع العربي الملتزم بقضايا وطنه وأمته، في ظل الحروب والصراعات السياسية والدينية والفكرية؛ إذ تصبح الحاجة إلى دمج الفن مع مشاهد الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الواقعية أكثر إلحاحا من اللجوء إلى النزعات الخيالية، والاستعانة بالرموز الأسطورية مثلا، فالمتلقي سئم من تجميل الواقع القبيح في ظل الأوضاع الراهنة مثلا، وأعتقد أن أدوات الخيال التجميلية أعلنت عن عجزها لقاء ما في الواقع من مشاهد الظلم والقتل والدمار، فالفن اليوم يعيش الظروف ذاتها التي عاشها أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وتحديدا في تأثره بالحربين العالميتين؛ الأولى، والثانية. مما جعله أكثر ميلا لتمثيل أحداث الحياة اليومية تمثيلا واقعيا، بعيدا عن أي تجميل، وذلك بانتقائه نماذج واقعية يرسمها بحسب انطباعه عنها، ليختزل بها الحالة الهدف، في عمل أشبه ما يكون بالتقاط صورة فوتوغرافية لحظة القبض على لقطة ما وتخليدها لتعكس حالة شعورية إزاء حدث، يمثل بدوره أحداثا، كما فعل مثلا الرسام الواقعي الفرنسي» جوستاف كوربي» في لوحته «كاسروا الأحجار» The Stone Breakers» «(1849) وكذلك هي أشبه بتجربة تولستوي الواقعية المنهج في معالجته موضوعة الحرب، ومساءلته كل ما حوله عن القيمة الإنسانية للحرب، في إطار سعيهم لترسيخ فكرة الفن الملتزم.
فتنقلنا رواية الكاتب الأردني هزاع البراري عبر بحرها الذي صُبِغ بالسواد؛ جراء توسطه منطقة عاثت بها يد الدمار، وآخرها ما يسمى الربيع العربي، وما تبعه من انقسامات طائفية ومذهبية وسياسية، ذلك الربيع الذي أصبح خريفا موغلا في خريف وإلى ما لا نهاية – وفق ما وصفه أبطال الرواية تقريبا - فيرى المتلقي عبر هذه الرحلة السوداوية مشاهد من واقع القهر العربي من حولنا، مُختزَلة في شخصيات من الواقع ذاته، تعكس مدى الاستجابة لحالة التشظي الكبير الذي تعيشه المنطقة، يتنقل الكاتب بينها بدون مقدمات، بما يتناسب مع الحدث والغاية؛ فلا حاجة له بالمقدمات في ظل الحدث الذي تمثله الشخصيات.
وتشكلت الرواية من ثيمات سردية؛ وذلك من خلال مجموعة سرديات أشبه ما تكون بمشاهد لعرض درامي واقعي، مرتبطة برؤية الكاتب في بنائه الشخصيات؛ فجعل من شخصية الصحفي كريم محور التقائها، كريم الباحث عن الحقيقة الإنسانية المشوهة، من خلال الصورة التي قدمها الكاتب لها، بأنها تمثل من جانب صحفيا، ومن جانب آخر شخصا واسع الاطلاع، وفيه من الوسطية والاعتدال وبعد النظر ما يجعله، ممثلا للسلم، وحاملا للوائه في بحثه عن الحقيقة. لذلك، جعل البراري من شخصية كريم محورا تدور حوله باقي الشخصيات، التي تمثل كل واحدة منها دولة من دول الجوار، في عمل أقرب للدراما الواقعية، إذ جسد الحالة في مشاهد اختزلت الواقع والشعور، ليتبين أن كريم تاه بين أمواج بحر أسود صبغته مآسي الشخصيات بسوادها، الشخصيات التي ظلت تدور حوله. فمثلا، ينقل كريم أخبار أبي حذيفة المصراتي الليبي كنقله أحاديث أبطال الرواية الذين تعهد بنقل أحاديثهم وأخبارهم، وكذلك أخبار رشا التي أصبحت صديقة كريم في العالم الافتراضي.
أما شخصية رشا، فهي تمثل الفتاة الفلسطينية التي تنتمي لعائلة هاجرت من يافا إلى الأردن، بعد هروب جدها من التزامه مع المقاومة الفلسطينية في لبنان، والذي أظهرت الأحداث بالتالي أنه اختار من ألمانيا منفى له. وبعد أن عثرت رشا على مكان جدها قررت الذهاب للعيش معه، ولكنها لم تستطع الاستمرار، فغادرته تاركة إياه في غيابات المنافي وبرودتها، لينتهي به المطاف إلى الانتحار.
وجسد في شخصية الشيخ أبو حذيفة المصراتي الليبي فكرة ملاحقة الموت والدمار للإنسان العربي، أينما ذهب وحل؛ نتيجة غرق المنطقة العربية بالدمار وتبعاته، إلى أن تشوه داخله وتحطمت إنسانيته. فأبو حذيفة هو شاب ليبي، يدرس ورفاقه في لبنان، رفاقه الذين قضت عليهم تعسفا آلة الحرب الهمجية، غير آبهة بطموحاتهم وأحلامهم؛ فيقرر الانتقال إلى مصر وينضم إلى جماعات وتنظيمات طائفية هناك، طلبا للتطهر من آلامه وأوجاعه، ولكنه كرفاقه يموت، ولكن يموت موتا نفسيا؛ فقد أبعد إلى بلاده بدون أدنى نتيجة تجنى، إذ تحطمت آمال وطموحات هذا الشاب وأهله بالحصول على شهادة علمية، لينعكس أثر هذا الفعل عليه، ليصبح تاجرا يحاول إقامة ثروته وسعادته على تعاسة المهجرين من أبناء جلدته.
ووجد لطفي الطبيب السوري وعائلته، وبعد معاناتهم مع الموت والظلم والقهر، أنفسهم رهائن للهجرة ومخاطرها كحل أمثل للخلاص غير المضمون من تردي الأوضاع؛ ليجد لطفي نفسه في مخيم بائس في تركيا، كان من الممكن أن يأسر طموحه وأحلامه، لولا شهادته ومكانته العلمية، ليعمل مع إحدى المنظمات الإغاثية، عملا ليس ببعيد عن المأساة التي خلفتها الحرب، لتتلاحق الأحداث، فيقضي لطفي وعائلته ضحية زلزال تركيا، في مشهد واقعي جسد حالة البؤس الفردية والجمعية بصدق، في قالب فني لم يتعد قصدا -إلى حد ما- التقنيات السردية واللغة الناقلة للحدث.
فسعى الكاتب بفعل تقنية تعددية الأصوات مثلا، إلى دمج المتلقي مع الشخصيات، بدافع الفضول؛ تمهيدا لما هو مستقبل من أحداث الرواية. إذ جاء اختيار هذه التقنية لما لها من فاعلية في جعل العمل مفتوحا على قراءات عدة، مما يستوجب بالضرورة إبقاء المتلقي على اتصال دائم مع الحدث، فيتمكن لقاء ذلك من تقديم قراءات من شأنها أن تكشف رؤية العمل. فمن الممكن أن يقرأ العمل مثلا، بأنه محاولة من الكاتب للانتصار للإنسانية التي شوهتها آلة الحرب. وذلك، بلفته النظر للبؤس الذي عاشه الإنسان العربي تحديدا في ظل الظروف الراهنة، ولكنها تبقى قراءة من قراءات عدة ممكنة في ضوء، سجل النص وفجواته، وكذلك وجهة نظر المتلقي الجوالة وقدرتها على التفاعل مع النص وكشف جمالياته.
وتمتاز لغة البراري عادة بفرادة تستوقف المتلقي؛ فهي لا تقترب من لغات الآخرين في شيء، وكأنه يقيم لنفسه مؤسسة لغوية خاصة، لا تعود إلى نموذج في الغالب، وتحديدا إذا أراد الكتابة في الشعرية العميقة، فإنه يغرق لغته بالإيحاءات المرهقة للقارئ أحيانا، أما عنها في هذه الرواية، فإنني في ضوء قراءتي الرواية، أجده في الغالب يكتب بلغة تنساب بسلاسة تتقاطع مع ثقل الأحداث التي عاشتها الشخصيات، وتقترب من المتلقي أيا يكن، فالحدث الذي تنقله يعد محور اهتمام أي قارئ يعد شاهدا على الأحداث، ولكننا نجده يعود إلى اللغة العالية متى استوجب الحدث الكشف عن مدى ثقافة الرواة وتنوع خبراتهم.
وعليه، نستطيع القول بأن البراري تمكن بفعل بنائه الروائي المميز أن يقدم رؤية واقعية للأحداث الراهنة في العالم العربي، من خلال رسمه مشاهد مغرقة في واقعيتها، شكلها بحسب انطباعه عنها ووفق ما علق منها في ذهنه، استطاعت هذه المشاهد بدورها أن تمثل حالة البؤس الفردي والجمعي التي يعيشها الواقع العربي بكل مكوناته؛ البشرية، والمادية. منتصرا في ذلك للإنسانية، ولحق الإنسان بالسلم والحرية، في إطار وجهته الملتزمة بإنسانيته بالدرجة الأولى، وبقضايا وطنه وأمته أيضا. وذلك، في تجربة يمكن تقديمها في عمل درامي يجسد بدوره أحداث مرحلة شكلت نقطة تحول في مصير الإنسان العربي.
*باحثة وطالبة دكتوراة في جامعة اليرموك
