عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
رياض كامل يخط دراسة في "الرواية العربية الفلسطينية- النضوج والارتقاء"
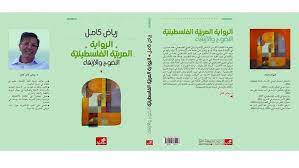
الغد-عزيزة علي
صدر عن دار الأهلية للنشر والتوزيع- عمان، كتاب بعنوان "الرواية العربية الفلسطينية-النضوج والارتقاء"، للدكتور رياض كامل.
وفي كلمة على غلاف الكتاب، يبين المؤلف أن هذه الدراسة "تهدف إلى تزويد القارئ ببعض المعلومات المهمة حول الرواية العربية الفلسطينية الحديثة عبر التوقف، بإيجاز، عند محطات مهمة في مسيرتها، وتبيان ما يميز هذا الإبداع عن غيره من الروايات العربية، وعلاقتها بأهم الأحداث التاريخية، وبالذات انعكاس النكبة على مجريات أحداث العديد من هذه الروايات، واحتفاء الرواية بالفضاء الفلسطيني، وتعريف القارئ على خصوصيات اللغة والمكان والزمان في الرواية العربية الفلسطينية".
في مقدمته، يقول كامل "إن المتابع لمسار الرواية في فلسطين يجد أنها لا تختلف عن مسار الرواية في كل من مصر وسورية. فقد اعتبر الباحثون أن روايتي "الوارث" التي صدرت في العام 1920 للكاتب خليل بيدس، ورواية "الحياة بعد الموت"، التي صدرت هي الأخرى العام 1920 للكاتب إسكندر الخوري البيتجالي، أول روايتين فنيتين فلسطينيتين"، لافتا إلى أن بعض المصادر تجمع على أن الرواية العربية الفلسطينية بلغت مرحلة النضوج على يد جبرا إبراهيم جبرا (1920-1994)، إميل حبيبي (1921-1996) وغسان كنفاني (1936-1972).
يوضح كامل، أن هؤلاء الثلاثة يرتبط بعضهم ببعض ارتباطا عضويا، نظرا لما لهم، معا، من دور مهم في دعم وتدعيم أسس الرواية العربية الفلسطينية. فقد قدم كل منهم، من موقعه الأيديولوجي والجغرافي، رؤية خاصة أسهمت في ترسيخ وتأصيل هوية الفلسطيني الذي عاش تجربة خاصة به، هي تجربة التهجير والتشتت، والحرمان من الطفولة ومن البيت، ومن حق العودة وإعادة بناء العائلة على المستويين الخاص والعام. وحظي الثلاثة باهتمام النقاد والدارسين في الشرق والغرب، وترجمت أعمالهم إلى لغات عدة.
يتحدث كامل عن جبرا إبراهيم جبرا، الذي نال شهرة واسعة في العالم العربي، وترجمت أعماله إلى لغات عدة. ولقد عرف جبرا بسعة اطلاعه على الثقافات الغربية، فقام بالدمج بينها وبين ثقافته الشرقية في أعماله الروائية. فقد اطلع جبرا عن كثب على الأدب الإنجليزي، منذ سن مبكرة، حيث انطلق منه إلى الغرب وحضارته، فوظف في كتاباته الأساليب والتقنيات الغربية الحداثية التي عرفها عن قرب من خلال دراسته الأدب الإنجليزي، التي بدأ من الكلية العربية في القدس التي كانت تدرس الأدب الإنجليزي للطلاب، وبالذات مسرحيات شكسبير، ثم دراسته اللغة الإنجليزية في أحسن الجامعات الإنجليزية التي وصلها بفضل تميزه ونجاحه في مدرسته.
ويقول المؤلف، إن جبرا بعد حصوله على شهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي، مما أهله لكتابة روايتين باللغة الإنجليزية، فقد كتب رواية "صراخ في ليل طويل" (1946)، التي أعاد كتابتها باللغة العربية سنة 1955، ورواية "صيادون في شارع ضيق" (1960) التي ترجمت هي الأخرى إلى العربية (1974)، لافتا إلى أن جبرا عمد في رواياته على توظيف تقنيات رواية تيار الوعي، والتناص والإحالات إلى الكتب المقدسة، وخاصة الإنجيل، فضلا عن توظيف الأساطير والموسيقا، مستفيدا من ثقافته التي اكتسبها من الغرب مباشرة.
ويشير كامل إلى أن جبرا ابتعد عن أسلوب الخطابة الذي كان متبعا سواء في الشعر أو في القصة والرواية، حتى بات في عين بعض الباحثين من رواد الحداثة في القصة والرواية العربية عامة، مؤكدا أن جبرا يعد من أوائل كتاب الرواية الحداثيين، وأحد أهم الأدباء في تاريخ الأدب الفلسطيني الحديث، وأنه شغل الدارسين والباحثين بالبحث والتنقيب، بفضل غزارة عطائه وتنوعه، وما يزال يشغلهم حتى اليوم.
ويقارن كامل بين جبرا الذي قدم رصيدا هائلا في حقول الأدب المتنوعة من خلال غربته في العراق، وبين إميل حبيبي، الذي بقي بعد النكبة يقارع من الداخل الوطن، من خلال واقع جديد مربك هو واقع العربي الفلسطيني الذي تحول، في وطن الآباء والأجداد، إثر تهجير غالبية سكان البلاد العرب الأصليين، من أكثرية مطلقة إلى أقلية داخل دولة تتبنى الفكر الصهيوني. ينظر العربي إلى ما كان وإلى ما صار؛ هنا هو مبتور عن شعبه وعن أهله المهجرين خارج الوطن، ويعيش تحت قوانين مجحفة وصادمة لا تجيز له زيارة الأهل والأقرباء والأصدقاء، حتى في داخل الوطن، إلا بإذن من الحاكم العسكري. وقد صودرت أرضه مصدر عيشه الأهم، وبات يبحث عن لقمة عيشه في المستوطنات التي أقيمت حديثا، أو تلك التي أقيمت على أراضي القرى العربية.
ويقول المؤلف، في ظل هذا الواقع الجديد الهجين شحن حبيبي بغضب عارم وألم عميق عبر عنه من خلال إبداعاته المتنوعة بدءا من قصة قصيرة بعنوان "بوابة مندلبوم" (1954) المستوحاة من قصة حقيقية؛ حيث اضطرت والدته لأن تتركه في البلاد لتلحق بابنها الأصغر المهجر في دمشق، فتموت هناك بعيدا عن الوطن، لتصبح بالتالي حكاية الفصل العنصري بين الفلسطيني هنا الذي كان جزءا لا يتجزأ من عالم عربي كبير ثم بات مقطوعا كليا عن محيطه الواسع، محروما من التواصل مع أهله ومع أبناء شعبه العربي.
وتابع حبيبي في رحلة الإبداع، فكانت "سداسية الأيام الستة" (1968) ثم روايته الشهيرة "الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل" (1974) التي اعتمد فيها على أسلوب المفارقة والسخرية السوداوية لتصوير هذا الواقع الهجين وكشف حالة الضياع التي يعيشها العربي في ظل دولة تسلب حق الفلسطيني في العيش بكرامة وتزيف هويته وتراثه وشعره وأدبه، هي في اعتقادي رواية الفلسطيني المشوه بفعل الواقع الجديد.
ولربما كانت عودة حبيبي في كتاباته إلى التراث العربي عامل تعويض عن خسارته على أرض الواقع، خاصة وأنه يكتب من أجل تثبيت الهوية العربية التي يصر الآخر على مصادرتها، إذ يبدو أن العرب كلما شعروا بتهديد وجودي عادوا إلى الماضي كملاذ يفاخرون به، وقد برز ذلك بشكل ملحوظ إثر حملة نابليون الغربية على الشرق العربي، فكانت هناك عملية إحياء للتراث العربي وظهور أنواع أدبية حديثة. واستلهم حبيبي مادة كتاباته من التراث، فخلق كتابة أدبية مغايرة تأخذ موضوعها من الحاضر وتؤثقه وتغنيه بأساليب القدامى، وتخلق في الآن ذاته أسلوبا جديدا في شكل الرواية العربية الحديثة.
ويرى كامل أن "غسان كنفاني"، الذي عاش تجربة النكبة بكل عذاباتها وتفاصيلها منذ التهجير القسري طفلا، فتنقل من بلد عربي إلى آخر، وذاق طعم هزيمة 1967 ومرها، فعبر عن ذلك من خلال مجموعة من إبداعاته التي بلغت ثمانية عشر مؤلفا، تشهد على عبقرية هذا المبدع الشاب، وعلى رؤيته المتطورة في التعامل مع الوطن والهوية. فكنفاني صاحب مشروع فكري فلسفي يضع فكرة حق العودة في سلم أولوياته، ويبني مشروعه وفق هذه الرؤية؛ الإنسان قضية والوطن قضية، فهو البيت والإنسان والشجر والماضي والحاضر والمستقبل.
كما أن كنفاني هو ابن الصدمتين: النكبة والنكسة. جرب النكبة وذاق مرها وهو طفل صغير، فكانت الصدمة الأولى التي تستوجب دراسات عديدة لتبيان مفهومها وأثرها على طفل يهجر مع أهله ويترك بيته وماضيه وذكرياته وأترابه. ولما عاد الأمل إلى العالم العربي وإلى الشعب الفلسطيني كانت الصدمة الثانية، "صدمة النكسة" (1967) وتحطم آمال الأمة العربية وهي ترى أحلامها تبعثرها الرياح وتذروها بعيدا.
ويقول كامل، إن الصدمة الثانية كان لها التأثير الكبير على المثقف العربي، وعلى المواطن العادي لأنها جاءت بعد قناعة كثيرين بحصول تحول سياسي في الشرق الأوسط يعيد الخريطة إلى ما كانت عليه قبل عشرين عاما، وصدرت روايات عديدة تصور هذا الواقع المتعثر، المؤلم والكئيب. ولكن كنفاني ذهب باتجاه آخر، فقد وجد أن تصوير الواقع المؤلم هو واجب، لكنه يبقى منقوصا إذا لم تفتح كوة للأمل. فكانت روايتاه "عائد إلى حيفا" (1969)، "أم سعد" (1969) كتابة الأمل رغم الألم، ودعوة إلى اتخاذ مسار فلسطيني مستقل، بعيدا عن إخفاقات الأنظمة العربية.
بالرغم من حماسة كنفاني السياسية وانتمائه الأيديولوجي المعروف الذي آمن به إلا أنه، في كتاباته، فهو أديب أكثر منه سياسي، إذ ابتعد عن الأدب الخطابي، مؤمنا أن الكلمة الهادئة تخترق الوجدان والعقل والعاطفة مثلما يخترق الماء الهادئ أعماق الأرض. ولهذا فقد اعتبرت روايته "رجال في الشمس" (1963) الرواية الفنية الثانية في فلسطين والأردن بعد رواية "صراخ في ليل طويل" لجبرا.
لم يدق كنفاني جدران الخزان في روايته "رجال في الشمس" فقط. فقد راودته هذه الفكرة في كل كتاباته السابقة واللاحقة. إن فكرة خلدون/ دوف في "عائد إلى حيفا" الذي أصبح جنديا في الجيش الإسرائيلي لهي فكرة في غاية الذكاء لدق جدران الخزان منعا لما يمكن أن تؤول إليه الأمور. فقد رأى أن فقدان الوطن قد يجعل الفلسطيني يفقد الأمل، فعمد إلى تجنيده فكريا، وتثويره ضد واقعه وشحنه بالإرادة، إذ من دون الإنسان ومن دون الذاكرة يختفي الوطن كليا. فهذا "سعيد س" بطل رواية "عائد إلى حيفا" يخاطب المرأة اليهودية التي سكنت في بيته، قائلا: "طبعا نحن لم نجئ لنقول لك اخرجي من هنا، ذلك يحتاج إلى حرب".
ويقول المؤلف، إن خلاصة هذه الدراسة أظهرت أن كتابات هؤلاء الأدباء الثلاثة هي في معظمها محصلة "الصدمة" التي تستحق دراسة أكبر وأوفى من المختصين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع. كان جبرا وحبيبي شابين صغيرين حين وقعت النكبة، وكان غسان حينها طفلا، ولما بعثت الآمال من جديد كانت النكسة الصدمة الثانية، فكان من الطبيعي أن تنال هاتان الصدمتان حيزا واسعا من إنتاجهم.
ويرى أن هزيمة 1967 كانت منبها إلى خلل شامل في منظومة وبناء العالم العربي عامة، وقد ظهرت إثر ذلك مجموعة من الكتابات الروائية العربية التي تبين الإحباط العربي وخيبة أمل العرب وفقدانهم الثقة بهذه الأنظمة، لكن صدمة الهزيمة كانت بالنسبة للفلسطينيين محفزا كي يعيدوا النظر فيما كان من قبل، وشهدت فترة ما بعد النكسة هبة جماهيرية فلسطينية تؤكد أهمية دور الفلسطيني في حمل دور الريادة، كما تجلت في أعمال هؤلاء الثلاثة وفي أعمال أدبية فلسطينية كثيرة.
ويشير المؤلف إلى أن المتابع يشاهد أن هناك أفكارا متشابهة فيما بين هؤلاء الثلاثة، وأخرى مغايرة وذلك وفق الجغرافيا والأيديولوجيا التي تبناها كل منهم. يشترك الثلاثة في التفكير بمستقبل أفضل وأكثر أمنا وأمانا كي لا تتكرر النكبة والنكسة. يرى غسان أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال مقاتل مؤمن بحقه بالعودة، ويرى جبرا أن ذلك يحتاج إلى إيمان فلسطيني داخلي بحق العودة، ويبحث حبيبي عن هوية فقدت فيراها في عودة الوعي.
ويتابع كامل "انطلق الثلاثة في كتاباتهم من خلال أيديولوجيا ترى أن الصراع ليس بين شعبين، إنما هو خلاف عقائدي بين فكرين متناحرين، فبنى كل منهم مشروعه على أساس نشر الوعي من ناحية ومصارعة الآخر من ناحية ثانية، وذلك يتطلب التوجه نحو ثلاث جهات على الأقل: الداخل الفلسطيني، والعربي عامة، والرأي العام العالمي، فكانت الترجمة التي قام بها جبرا مشروعا تثقيفيا مهما موجها للعربي حيثما تواجد، وكانت كتابات كنفاني وحبيبي ومقالاتهما السياسية موجهة إلى كل الجهات، وكانت الأعمال الأدبية على اختلافها كتابات مؤدلجة لتجنيد الداخل والخارج وشحن الإرادة العربية وإعادة الثقة بالذات في ظل هزيمتين كبيرتين: النكبة والنكسة".
