عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
رواية أنا يوسف يا أبي للدكتور باسم الزعبي
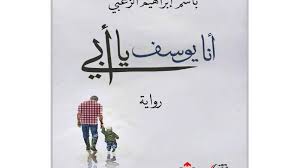
الدستور-الدكتور سلطان المعاني
تُشكِّل رواية «أنا يوسف يا أبي» عملاً اجتماعياً إنسانياً ينهل من مرجعية العائلة والتاريخ، ويتقاطع مع واقعية يومية شديدة الوطأة، ليعيد صياغة أسطورة يوسف على أرض الواقع العربي الحديث، ضمن سردية معاصرة تدور بين الأردن وروسيا. وتستلهم الرواية عذابات يوسف القرآني، لكنها تضعه في قلب حاضر مضطرب، يتوزع فيه الألم بين الغربة، والتحولات الاجتماعية، والأسرة المنقسمة، والتاريخ الوطني بكل جروحه. تدور الأحداث حول شخصية «عون» الذي يقرر الهجرة إلى روسيا بعد أن أُحيل إلى التقاعد قسرًا من عمله، وتراكمت عليه الخيبات المعيشية والوظيفية، وأصبح يعاني من أزمة هوية وأمل. تتشابك في حياته خيوط عائلية متشعبة: زوجته الروسية «غالينا» التي تعيش صراعًا داخليًا بين هويتها الأممية وحنينها للماضي، وابنه «محمد» الذي يعاني بدوره من ضياع الجيل الجديد بين ثقافتين، وأخته «عائشة» التي تبقى رمزًا للدفء والحنان وعمق الجذور. تطغى على الأحداث ذكريات الأم الراحلة «فاطمة»، وحواراتها المؤثرة مع ابنها التي تفيض بحنين الفقد واللوم والعتاب، وكذلك صداقات الماضي مع «صالح»، الذي يجسد نموذج الصداقة القديمة وصوت الضمير الاجتماعي. وتستحضر الرواية عبر شخصياتها أجواء الحروب، وانكسارات العائلة العربية؛ فالأخوة متباعدون، الصداقة متآكلة بفعل تغير الزمن، الأم حاضرة في الضمير رغم غيابها الجسدي، الأب يختنق تحت ثقل القيم القديمة وعجز الواقع. وتبقى الأسئلة الوجودية معلقة حول مصير الإنسان خارج جغرافيا الوطن، وكيف يمكن للغربة أن تعالج جراح الروح أم أنها تزيدها عمقًا؟
تجمع لغة الرواية بين الشاعرية والتقريرية، وتلعب على التوازي بين الأسطورة والراهن: «أنا يوسف يا أبي» يتحول فيها يوسف إلى أي إنسان عربي يجد نفسه غريبًا بين أهله، منفيًا في قلب وطنه أو في بلاد الآخرين، متهمًا بلا ذنب، تائهًا بين قسوة الإخوة وحزن الأب. وتفتح الرواية باب الأسئلة ولا تغلقه، تترك القارئ أمام جراحه وأمام أبواب المطارات التي لا تؤدي دائمًا إلى خلاص، وربما إلى دورة جديدة من التيه والبحث عن الذات.
ويتسم النسيج الروائي بتركيب سردي متداخل، يُغلفه الحنين، وتنسجه المشاهد اليومية والذاكرة والحوار الداخلي، حيث تتقاطع الخيوط الزمنية والشخصيات في نسيج كثيف يعكس واقع الإنسان العربي المعاصر وهمومه. وأول ما يلفت الانتباه في هذا النسيج هو الحضور القوي للذاكرة؛ فالسرد ينفتح دوماً على الماضي، سواء في استدعاء مشاهد الطفولة، أو استرجاع لحظات الفقد، أو استحضار حوارات الأم والأب والصداقات القديمة. الذاكرة في الرواية فاعل رئيسي، تُعيد إنتاج الحاضر عبر استدعاء صور الماضي وأصواته، حتى تبدو الشخصيات أسيرة زمنين في آن واحد: زمن الحاضر المضطرب، وزمن الأمس الذي يوشك أن يصبح أطلالاً.
وتحضر الحوارات الداخلية كخيط آخر في النسيج، حيث تتداخل الأفكار والهواجس والعتاب الذاتي في تدفق أشبه بمونولوج طويل، يجعل القارئ شريكاً في الانفعالات النفسية للشخصيات. فـعون-على سبيل المثال- لا يتوقف عن محاورة ذاته أو استحضار صوت الأم الغائبة أو التحاور مع شقيقته «عائشة». هذه الحوارات الداخلية تمنح السرد عمقاً إنسانياً، وتجعل كل فعل صغير؛ كإغلاق حقيبة السفر، أو شرب القهوة، أو المرور على قبر الأم؛ محملاً بإيحاءات ودلالات أكبر من ظاهره.
أما بنية الشخصيات، فتقوم على تقاطعات اجتماعية وثقافية متعددة. حيث الرواية تخلق فضاءً روائياً واسعاً تُطل منه زوجة روسية، وأبناء يعيشون في ازدواجية الثقافة، وأصدقاء قدامى تبدلت ملامحهم، وأخوة متباعدون بالوجدان والمصير. هذا التداخل يُنتج نسيجاً إنسانياً مُتشابكاً يُحاكي واقعية الأسرة العربية الممتدة والذاكرة الوطنية المجروحة.
كما يعتمد النسيج الروائي كذلك على الحوار الخارجي الذي يمتزج غالباً بالحنين واللوم والعجز، وتكاد كل الجمل فيه تحمل ثقل الأسئلة والتوترات المكبوتة بين الشخصيات. فالحوار بين عون وأخته عائشة، أو عون وصديقه صالح، كشف عما تخفيه الجراح الشخصية والجراح الجماعية، وهو محاولة لفهم ما لا يُفهم في حاضر تتسارع تحوّلاته.
وفي قلب هذا النسيج، تتكرر الرموز: الغربة، والبيت، والمطار، والقبر، والقميص، والجب، كلها إشارات حية تعيد إلى ذهن القارئ أسطورة يوسف، لكنها تذوب في واقع الرواية وتتشكل حسب معاناة كل شخصية؛ فـالجب شعور بالنبذ، والغربة سفر إلى روسيا، واغتراب داخلي متجذر في الذات في آنٍ.
وتشكل لغة الرواية نفسها جزءاً من النسيج، فتجمع بين السرد الشاعري والتقرير الواقعي، وتنتقل بسلاسة بين الحوار والفكرة والتأمل، مع استخدام ذكي للإشارات القرآنية والأمثال الشعبية والحكم، في توليف يجعل النص معلقًا بين الموروث والحداثة.
وبالمجمل فإن نسيج «أنا يوسف يا أبي»، هو نسيج متشظٍ، متداخل، لكنه متماسك عبر قوة العاطفة وحضور الحنين وشبكة الرموز. إنه نسيج يصنع من حكاية فردية صورة جمعية لوجدان جيل كامل، يعيش التمزق بين الوطن والمنفى، وبين سلطة الأسرة وسطوة القدر.
ويتبدى التماسك الروائي بوصفه السمة الأبرز التي تضمن للخطاب السردي وحدته، رغم تشظّي الأزمنة وتداخل الأصوات وتعدد الرؤى، إذ ينجح الزعبي في بناء رواية متماسكة تُمسك بتلابيب القارئ منذ اللحظة الأولى، وتعبر به من مشهد إلى آخر دون أن يفقد الإحساس بخيط السرد المركزي أو تضيع منه ملامح الشخصيات. ويتحقق هذا التماسك عبر جملة من التقنيات الفنية والاختيارات البنيوية، حيث يوظّف الزعبي تقنية تعدد الأصوات الداخلية والخارجية، وتتوزع السردية بين ضمائر مختلفة، وتفسح المجال للأصوات الفرعية (الأم، الأخت، الزوجة، الابن، الصديق). هذا التداخل في الأصوات يُعمِّق النسيج، ويمنحه حيوية وديناميكية، إذ يصبح كل صوت حاملاً لجراحه وأسئلته، ويثري البناء النفسي للشخصية. وينجح الكاتب في المزاوجة بين الواقعية الاجتماعية الصارخة وأسطرة الحدث عبر استدعاء قصة يوسف القرآنية، معيداً إنتاج رموزها في بنية معاصرة: الجب، والقميص، والغربة، واتهام الذئب، والغيرة الأخوية، إلى آخر ذلك من استدعاءات تُذوِّب الأسطورة في تفاصيل الواقع، وتجعلها ملمحاً سردياً يتكرر في مسارب الرواية.
ويحتفي العمل بالحوار الداخلي الطويل، حيث تُفتح أعماق الشخصية على مصراعيها للتأمل والتساؤل، لا سيما عند بطل الرواية (عون). فالمونولوج تقنية للبوح، ووسيلة للكشف عن تآكل الداخل أمام أزمات الخارج، وعن عجز الفرد أمام وطأة العائلة والحنين والفقد. وتستثمر الروايةُ الرمزَ بكثافة، وتمنح الأشياء اليومية (القميص، والجب، والمطار، وحقيبة السفر) طاقة دلالية مضاعفة. فكل تفصيل صغير يُحمّل بمعانٍ كبرى تضع القارئ أمام شبكة رمزية تربط الماضي بالحاضر، والتاريخي بالراهن.
يتحرك السرد بين الحاضر والماضي باستمرار، يتعرج مع الذكرى، ويقفز بين الطفولة والشباب وراهن الهجرة. هذه التقنية تُحاكي التدفق الحر للذاكرة الإنسانية، وتجعل القارئ دائم الحضور في جميع أزمنة البطل، دون شعور بالانفصال أو فقدان للتماسك.
وتعتمد الرواية في كل هذا لغة مشحونة بالعاطفة، تمتزج فيها البلاغة بالحوار العادي، والجملة الشعرية بالجملة التقريرية. هذا التداخل الأسلوبي يمنح النص تماسكاً إيقاعياً، ويعزز من قدرته على خلق مناخ وجداني متصل من البداية حتى النهاية.
ورغم تداخل خيوط الشخصيات والحوارات والذكريات، تبقى وحدة الموضوع واضحة: الاغتراب، والبحث عن الأمان، وهشاشة العائلة، وجرح الوطن. لا تسمح الرواية لأي مشهد أو حدث أن يبتعد عن مركز الأسئلة الكبرى التي تطرحها، ما يكرس التماسك ويجنب العمل الوقوع في التفكك أو التشتيت.
وبالمجمل فإن تماسك رواية «أنا يوسف يا أبي» يتجلى في قدرتها على توحيد عناصر متفرقة تحت مظلة بناء سردي متين، مستعينة بتقنيات روائية حداثية، لتصوغ عملاً يستبطن أوجاع الإنسان العربي، وينحت من تفاصيل حياته العادية نصًا يحتفي بالذاكرة ويقاوم الفقد ويؤسس لجمالية سردية فريدة.
تكشف الرواية عن تكامل في العناصر الروائية، حيث لا ينهض النص بوظائفه الجمالية والمعرفية إلا عبر تداخل وتساند النص والمكان والزمان والشخصيات والبنية السردية، فتتشكل لوحة سردية حية، تحاكي الحياة في كثافتها وتعقيدها.
يتسم نص الرواية، كما أشرنا سالفاً، بمرونة عالية بين الشاعرية والتقريرية، ويعتمد على إيقاع داخلي يشد القارئ عبر تقنيات التداعي، والانفتاح على الذاكرة، والتوتر الحواري المستمر. ويصبح النص نفسه بمثابة فضاء نفسي، يتحرك فيه السرد بحرية بين ضمير المتكلم والغائب، ويتيح للأصوات الداخلية أن تتفاعل في حوار لا ينقطع مع الخارج ومع الذات. كما يحمل المكان في الرواية أعباء الشخصيات وتناقضاتها، ويتحول إلى مرآة للذاكرة والهُوية والجراح. فالبيت، والقبر، والمطار، والمدينة، والوطن كلها فضاءات تتناوب على تمثيل الطمأنينة والأصل والدفء، أو القلق، والمنفى، والوحشة. ويكتسب المكان مع كل انتقال أو وداع معنىً جديداً. ويظل «البيت» مركزاً رمزياً لفقدان الأم، وانكسار الأسرة، واغتراب البطل، بينما يتحول «المطار» إلى بوابة للأمل المرّ أو الهروب القسري. فيما تتحرك الرواية بين أزمنة متداخلة: الحاضر المتعثر، والماضي المستدعى بقوة الذكرى، والمستقبل الغامض الذي يشكّل هاجس الشخصيات. وتقوم التقنية الزمنية على القطع الزمني والتداعي الحر، بحيث يظل البطل أسير حوار لا ينقطع مع ماضيه، بينما يبقى المستقبل مفتوحاً على احتمالات التيه أو الخلاص. يتجلى الزمان في «يوم السفر» كعتبة رمزية بين عالمين، وفي لحظات الذكرى التي تستحضر كل ما فُقد أو تغيّر.
وقد جاءت الشخصيات في «أنا يوسف يا أبي» مرسومة بدقة، لها أصواتها وخلفياتها النفسية والاجتماعية، وتتكامل فيما بينها لتشكّل شبكة علاقات معقدة. البطل «عون» يُجسِّد الإنسان المهزوم أمام ضغوط الحياة، بينما تتوزع بقية الشخصيات -الأم، والأخت عائشة، والزوجة غالينا، والابن محمد، والصديق صالح- بين أدوار الحاضن، والناقد، والرمز، والضحية. وتتجاوز الشخصية الوظيفة السردية، إلى مستوى الكائن الكامل الذي يحمل تاريخه وهواجسه وأحلامه، مما ينعكس في الحوار والحركة والذاكرة. وبذا تنفتح البنية الروائية نفسها على التعدد، فتحتمل المونولوج، والحوار، والاسترجاع، والتشظي، لكنها تتماسك بقوة السؤال المركزي عن الانتماء والفقد.
تلعب هذه العناصر دورها في تحقيق رسالة الرواية: فضح هشاشة الكيان الأسري، ورصد معاناة الإنسان العربي المعاصر بين السلطة والقدر، بين الغربة الداخلية والخارجية. حيث يوظف النص كل عنصر ليكشف التناقضات: فالمكان يفضح التمزق، والزمان يكشف هشاشة الذاكرة، والشخصيات تمثل أجيالاً وأنماطاً اجتماعية متباينة، والبنية تحتضن الصراع بين التشتت والرغبة في التماسك.
وتندمج كل هذه العناصر في نسيج واحد، لتجعل من «أنا يوسف يا أبي» رواية متكاملة من حيث البناء والوظيفة، رواية تُخاطب الوجدان الجمعي كما تُشبع الذائقة الجمالية، وتعيد عبر تفاصيلها رسم معالم الغربة والحنين والبحث عن الذات، في عالم يتغير بوتيرة لا ترحم.
وتصنيفاً تنتمي هذه الرواية إلى فن الرواية الواقعية النفسية ذات البنية الرمزية، إذ تنفتح على عوالم الإنسان الداخلية وتشتبك مع همومه الاجتماعية، وتعمل على تسجيل ملامح الواقع، وتتوغل في أعماق الذات، وتكشف صراعاتها وهواجسها وتيهها بين فقد الأم وحيرة الأب وغربة الأسرة. يُحضر الكاتب رموزاً أسطورية ليعيد إنتاجها في فضاء معاصر، فتصبح قصة يوسف القرآنية مرآة لجراح الشخصية المحورية، وتنعكس عبر تفاصيل الحياة اليومية، من الجب إلى القميص إلى رمزية البيت والمطار والغربة. تلتقط الرواية نبض اللحظة العربية بكل ما يعتمل فيها من هشاشة الأسرة، وشعور الانكسار أمام السلطة، وتحولات المجتمع المعاصر، وتبني عوالمها على تداخل الحاضر والماضي والذاكرة، من خلال تداعيات الحوار الداخلي، وأصوات الشخصيات المتعددة، وكثافة الرموز والإحالات.
وعلى المستوى النقدي، تستدعي هذه الرواية مقاربة متعددة الأدوات والمنظورات، إذ يناسبها المنهج النفسي التحليلي، لما في النص من اشتغال عميق على تدفق الوعي والصراع الداخلي وحضور الطفولة والأمومة والفقد، كما يفيد المنهج البنيوي والسيميائي في تحليل شبكة الرموز والدوال التي تنتظم النص وتحمله من مستوى السرد الواقعي إلى أفق الرمز والأسطورة. كذلك يمكن للمنهج الاجتماعي أن يُبرز تمثيلات البنية الأسرية وتحولات المجتمع وصراعات الفرد مع محيطه. أما المنهج الرمزي أو الأسطوري، فيفتح باب قراءة أعمق لآليات توظيف الموروث الديني والأسطوري في بناء العالم الروائي المعاصر، وكيف تتحول قصة يوسف إلى وعاء جديد لمعاناة الإنسان العربي اليوم. بذلك، تظل الرواية نصاً مفتوحاً، يغري بالتأويل، ويحتاج إلى قراءة نقدية مركبة تتجاوز التصنيف الواحد، وتحتفي بتداخل النفسي والاجتماعي والرمزي في آن واحد.
أما المؤلف فيحضر في الرواية حضوراً خفياً ولكنه نافذ، يطل من بين السطور ويُشعر القارئ بأن كل تفصيل، وكل جرح، وكل حوار داخلي هو جزء من سيرة أو بوح شخصي، حتى وإن تمثّل في أقنعة الشخصيات أو تماهى مع صوت الراوي. يظهر حضور المؤلف عبر اختياره السردي الذي يميل إلى البوح الحميم والانغماس في التفاصيل اليومية للبيت، والأسرة، وطقوس الوداع، والفقد، كما يتجلى في الوعي العميق بالزمن والذاكرة والحنين إلى الماضي، وفي استحضار رموز الأمومة والغربة والطفولة، وفي طريقة معالجة موضوعات الهزيمة والانكسار والتوق إلى النجاة أو الخلاص. ويحيل المؤلف القارئ دائماً إلى منطقة ملتبسة بين الذاتي والموضوعي، ويجعل من الشخصيات مرآة لانفعالاته وتساؤلاته، ويمنحها من روحه ما يجعل الرواية أقرب إلى نص اعتراف جماعي تتداخل فيه تجربة الكاتب مع جراح جيله وهموم الناس من حوله. كما يتسلل حضور المؤلف من خلال التقنيات التي يعتمدها في البناء، إذ ينحاز إلى لغة شاعرية وإلى الاستبطان النفسي، ويميل إلى تدوير المشاهد بين الحلم واليقظة، ويكشف عن حس نقدي واضح تجاه الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي. تظهر خبرته بالحياة وهموم الإنسان العربي في كل انتقالة زمنية أو جغرافية أو عاطفية، وتلمس قدرته على بناء عالم متعدد الطبقات ينقل فيه تجربته الخاصة إلى ما يشبه السيرة الجمعية. هكذا، يغدو حضور المؤلف في «أنا يوسف يا أبي» حضوراً ممتداً، يتجاوز حدود التوقيع على الغلاف أو ضمير المتكلم، ليصبح حضوراً شعورياً ومعرفياً وإنسانياً يُضفي على الرواية صدقها وفرادتها.
